قيس الزبيدي: الإخراج اختصاص والسيناريو اختصاص
ولد المخرج والباحث السينمائي قيس الزبيدي في بغداد، لكنه يبدو وكأنه لم يعد يعثر على المكان الذي ولد فيه، بعد تراكم السنين والحروب، مثلما لم يعد يعثر على جنسية. إذا سئل لا يعرف كيف يجيب، مع أنه يفضّل القول إنه فلسطيني، حيث كرس عمره وبحثه وسينماه في خدمة القضية الفلسطينية. لم ينتج عن العراق سوى فيلم وحيد كان عن التشكيلي العراقي البارز جبر علوان، ولا يجد نفسه معنياً بأن يصور وأن يصنع سينما هناك. يعتبر الزبيدي أن فيلماً حققه أواخر الستينيات عن أطفال اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في دمشق شكّل هويته وطريقه. من هناك شق طريقه إلى دائرة الثقافة في منظمة التحرير، ليحقق العديد من الأفلام التسجيلية حول القضية، ثم يتابع باحثاً في العديد من الكتب والأبحاث، بل ومبرمجاً ومنشطاً لسينما القضية في العديد من المهرجانات، العربية والدولية. «السفير» التقت المخرج الذي يقيم بين دمشق وبرلين على هامش «مهرجان دمشق السينمائي»، وكان هذا الحوار:
÷ لماذا يجري تقديمك في المهرجانات على أنك مخرج فلسطيني؟ 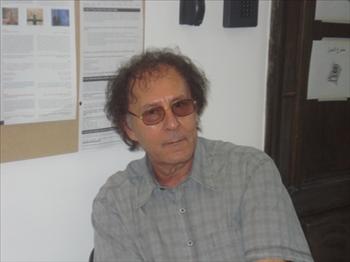
} أول ما جئت إلى سوريا كان أول فيلم أخرجته في التلفزيون «بعيداً عن الوطن» (1969) ثم «نداء الأرض» وأخرجت في المؤسسة العامة للسينما فيلم «شهادة الأطفال الفلسطينيين زمن الحرب»، ثم اشتغلت لفترة طويلة في دائرة الثقافة في منظمة التحرير، حيث كنت مسؤولاً عن قسم السينما، وفيها عملت مجموعة أفلام منها «وطن الأسلاك الشائكة» و«فلسطين سجل شعب».. كنت احضر المهرجانات وأسافر مع الوفد السينمائي الفلسطيني، وكانت أولى زياراتي لبغداد بعد سفري عنها لفترة طويلة، إما مع الوفد السينمائي السوري أو بعدئذ الفلسطيني. حين كنت عضواً في لجنة التحكيم في أحد مهرجانات دمشق احتاروا كيف يقدمونني فابتكروا تعريف المخرج العربي. الألمانية اليوم هي جنسيتي المكتسبة، وهذا زاد الأمور تداخلاً. لطالما جرى وصفي بأنني فلسطيني الانتماء. في الاسكندرية صدر كتاب لتكريمي بعنوان «عاشق فلسطين». والحقيقة أنني أتضايق من وصفي كمخرج عراقي، فأنا كسينمائي لم أصور حتى صورة فوتوغرافية واحدة في العراق، وحين أقدم على أنني المخرج العراقي يبدو وكأنني جئت من العراق، أو اصنع أفلامي فيه أو انني أمثله. حين أسأل من أين أنت؟ أفكر كثيراً حتى أرد، والجواب يأتي حسب مقتضى الحال. أحياناً أقول لهم إنني ألماني، فيقولون أنت تتقن العربية أفضل منا!
أعتقد أن فيلمي الأول «بعيدا عن الوطن» عن مخيم للفلسطينيين هو مخيم سبينة صار عنواني من دون أن أقصد. هناك تجربة مميزة في هذا الفيلم، وربما أكون أخذت الجائزة بسببها (الجائزة الفضية في مهرجان لايبزغ) فقد أخذت الأطفال بعد التصوير إلى استوديو الصوت، عرضت عليهم ما صورته عنهم، فراحوا يتصايحون فرحاً وشجاراً، أخذت الصوت وركبته على الفيلم، مما أضاف إلى الفيلم ميزة ولمسة.
÷ إذاً لم تكن على خلاف مع العراق؟ ماذا يعني لك العراق اليوم؟
} أنا خرجت من العراق للدراسة وعدت إلى سوريا للعمل، دعيت مرات مع غيري على مستوى رفيع لأعمل أفلاماً في العراق. لكن الشيء الوحيد الذي عملته عن العراق هو الفيلم الذي حققته قبل عامين عن الرسام التشكيلي العراقي جبر علوان، وعرض في مهرجان الخليج، ونال الجائزة الأولى. لا أحب اليوم أن أذهب إلى العراق كي أعمل فيلماً ومعي تمويل خارجي. حين سقط النظام أنتج كثيرون أفلاماً وحصلوا بسببها على الدعم. أنا لم يكن عندي مشروع لفيلم عن العراق.
المثقفون كانوا كلهم يعيشون خارج العراق، بعد الاحتلال وجدت عائلتي مشتتة في سوريا والأردن وسواها، والوطن هو العائلة، وجهت لي دعوة إلى العراق للمساهمة في تأسيس جديد للسينما، ولم أذهب.
÷ عملك في الفيلم التسجيلي هل هو خيار أم حل إنتاجي؟
} اكتشفت السينما التسجيلية وأهميتها في مهرجان لايبزغ منذ كنت طالباً في معهد السينما، وكنت اعتقد وما ازال في أن يؤسّس لسينما تسجيلية في البلاد العربية، لتكون هي أساس للسينما الروائية ومنطلقها. لأن الجمهور إذا اعتاد أن يرى واقعه على الشاشة سيتعلم أن ليس مهمة السينما فقط أن تروي له قصصا خيالية ملفقة إنما ان تروي له قصصا واقعية مكتشفة. والفيلم التسجيلي يفتح الشاشة على الواقع لمواجهته وتصويره عن طريق النزول إلى الشارع، مع انه يواجه أحيانا الرقابة والمنع، إلا انه يمنحك الخبرة والتجربة. وهذا من شأنه أن يقود إلى سينما روائية صادقة. في كوبا لم تعد تفرّق بين فيلم روائي وآخر تسجيلي. السينما التسجيلية هي هوية وذاكرة الناس، ذاكرة حقيقية لا ملفقة.
حين جئت إلى سوريا كان هدفي أيضاً أن أعمل سينما تسجيلية وبدأت العمل كمصور ومومتير واشتغلت لسنوات استمرت طويلا أفلاماً روائية طموحة اشتغلت مع نبيل المالح، محمد ملص، عمر أميرالاي، محمد شاهين، خالد حمادة، كريستيان غازي، مارون بغدادي، قاسم حول، غالب شعث.
المشكلة أن ليس لدينا مختبر لتجارب السينما، في مصر كان هناك تجربة لم تستمر، حين أعطي شادي عبد السلام فرصة لكي يعمل أفلاماً تجريبية. السينما مختبر. في روسيا صار هناك سينما بعد ثورة أكتوبر وبعد تجارب مختبر كوليشوف عملوا معجزات.
اليوم لديك مثلاً في سوريا ولبنان وسواهما من الدول العربية كم هائل من الأفلام بسبب سهولة عمل الأفلام. لكن ما يحدث أن المشتغلين غير مؤهلين. تجربة أميرالاي في «المعهد العربي للفيلم» في عمّان كانت مختلفة ومهمة في سياق تاهيل سينمائيين شباب جدد.
÷ هل ترى أن الفيلم التسجيلي اليوم يقدم القضية بشكل صحيح في أوروبا؟
} بعد عام 82 فُقد كل ما عمل من افلام فلسطينية. عملت مشروعاً في ألمانيا حاولت أن أجمع ما يمكن. وقد جمعت بالفعل 70 فيلماً عربياً وأوروبياً، كأفلام المخرجين الذين قدموا في السبعينيات أعمالاً عن فلسطين. حاولت مراراً وتكرارا «تنظيم برامج عن فلسطين في السينما الأوروبية». عملت ذلك في دورتين من مهرجان دمشق»، ومرة في الاسماعيلية ومرة روتردام، ومرة في مهرجان أبو ظبي تحت عنوان «تقسم فلسطين» . وتمت دعوة مخرجي تلك الافلام وكان من بينهم مخرجان ألماني وهولندي، بعدها عمل كل منهما فيلماً، الأول وهو روبرت كريغ عمل «أطفال الحجارة، أطفال الجدار» بعد زيارة إلى فلسطين.
وهو عن حياة خمسة أطفال فلسطينيين التقطت لهم صورة عام 1989، في بيت لحم، وهم من الجيل الذي أطلق عليه جيل «أطفال الحجارة». ومن الصورة ينطلق الفيلم ليرصد التحولات التي طرأت على سكان بيت لحم، وما حل بالفلسطينيين طوال تلك السنوات.
أما المخرج الهولندي جورج سليوزر، الذي سبق ان أخرج ثلاثة افلام عن عائلتين فلسطينيتين، مسلمة ومسيحية، في بيروت، فقد عاد وهو الآن شبه مشلول، فأخرج فيلم «وطن» وتابع البحث، وهو مريض وشبه مشلول، عن مصير افراد العائلتين بعد كل تلك السنوات الطويلة مستعيناً بمادة أفلامه السابقة وعمل فيلمه الجديد «وطن» الذي نال جائزة كبرى في المهرجان. هناك كثر في أوروبا تخصصوا بالموضوع الفلسطيني، وكان هدفي وما يزال إحياء أفلامهم وتحريض بعضهم على عمل افلام جديدة عن فلسطين. مع الأسف أن ليس لدينا الوعي المؤسساتي، فأنا الوحيد الذي عملت لأول مرة فيلماً عن المقاومة الوطنية في لبنان «واهب الحرية» (90 د) بدعم من الحزب الشيوعي اللبناني، وقد نال الجائزة الذهبية في مهرجان دمشق، لكنه لم يعرض في أي تلفزيون. ليس لدينا وعي بالإعلام وبالصورة. اذهب إلى العراق أو لبنان، لن تجد سوى محطات تلفزيونية تنتج ما يخدم هذا الحزب أو ذاك الفصيل.
÷ باعتبارنا نتحدث في أجواء «مهرجان دمشق السينمائي»، كيف تفسر غياب السينما الفلسطينية عنه؟
} العام الماضي رشحت للمهرجان فيلم «ملح هذا البحر» للفلسطينية آن ماري جاسر. وعملنا ندوة عن السينما الفلسطينية. باستمرار كان هناك مسعى لأن يكون أفلام عن فلسطين. إذا عدت إلى أفلام السينما السورية في السبعينيات تجد أنها كلها عن فلسطين.
أنا تعرفت على الموضوع الفلسطيني من الأفلام نفسها التي اشتغلتها، في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى أفلام ساهمتُ في مونتاجها. بالنسبة لـ«مهرجان دمشق» إذا لم يتوفر الفيلم الروائي الفلسطيني يمكن عرض أفلام تسجيلية مناهضة لإسرائيل. أفلام عن الجدار وغزة ورام الله. من يبحث عن أفلام للعرض يجد. كذلك فإنه لا يجب أن نخضع الفيلم الفلسطيني لمفهوم العرض الأول والثاني. أما عن عناصر إسرائيلية في الفيلم الفلسطيني فإيليا سليمان لم يعد إنتاجه اسرائيلياً. يمكن التذكير أيضاً بأن أفضل من عمل أفلاماً عن القدس هو المخرج الإسرائيلي عاموس غيتاي، الذي يمكن أن يأتي في سياق «من فمك أدينك». هناك مخرجون إسرائيليون ينتقدون إسرائيل بشدة، وهناك مخرجون ينتجون في فرنسا مثلا، مثل سيمون بيتون التي عملت أفلاماً عن محمود درويش وعزمي بشارة وسواهما. لكن يبدو أن هذا موضوع سياسي يحتاج إلى قرار أبعد من المهرجان.
÷ ما هي مشكلات التسجيلي في بلادنا؟
} شئنا أم أبينا فإن الفيلم التسجيلي يكشف. إذا كان حقيقياً عليه أن يكشف أسباب الفقر والبطالة وسواها، وهنا غالباً يأتي اعتراض الجهة المنتجة. التسجيلي يستفيد من المناخ الديموقراطي الموجود لحل المشاكل، من أجل تجاوزها. المؤسسات والوزارات تتحسس من هذا الأمر. حتى في لبنان تجد أنهم يراعون الحساسيات العربية. عموما يصطدم الفيلم السياسي التسجيلي بالسلطة بهذا الشكل او ذاك ويعرف تاريخ السينما محاولات لصنع افلام حتى سرية كما سبق غوتسمان أن فعل في فيلمه معركة تشيلي، حيث صور الفيلم بعد ان دخل إليها بشكل سري.
هنا ترى أن المسلسلات السورية استطاعت أن تحكي عما لم تستطع السينما السورية أن تحكي عنه. إحدى مشاكل التسجيلي أن جهات الإنتاج غالباً ما تكون رسمية. تستطيع أن تحكي عن محو الأمية وبناء السد العالي، أما أن تكشف وقائع وحقائق تطالب هذه الجهة أو تلك بحلها فهذا صعب انتاجه.
÷ لماذا لم تعمل أفلاماً روائية؟
} كان من الممكن أن أعمل فيلماً روائياً عن فلسطين، لكنني كنت أريده ضمن مواصفات حديثة في السرد، وأن يكون فيه بحث كي يكون صالحاً للعرض في العالم وليس هنا فقط. لا نريد لهذه السينما فقط ان تتحقق بتمويل خارجي، كما فعل يوسف شاهين، أو كما يفعل السينمائيون في الجزائر مثلا. مهم ان ننتج افلامنا وفقا لشروط ظروفنا وبالطريقة التي نريد ان نحكي فيها عن واقعنا لكن بطموح سينما بذات مواصفات السينما القومية في العالم.
÷ أية شروط؟
} منطقياً لا أحد يضع أموالاً إلا ليطابق بين تصورات منجز الفيلم وبين الجهة المنتجة. هناك استثناءات بالتأكيد، كفيلم «الليل» لمحمد ملص، أو «صندوق الدنيا» لأسامة محمد. أما قضية فلسطين فلا شك أنها شديدة الحساسية ومعقدة اكثر لمنتجي السينما.
÷ كيف جاءت تجربة فيلمك الروائي الوحيد «اليازرلي»؟
} كان فيلماً تجريبياً عرضته في النادي السينمائي، وهوجم بشدة، واتهم بأنه معادٍ للعمال وأن فيه دعارة. لكن الفيلم بيع، وعندما تغيرت إدارة المؤسسة العامة للسينما نشر خبر في الصحف يعتبر إلغاء بيع الفيلم إنجازاً. حين تغيرت إدارة المؤسسة مرة أخرى طلب مني إعادة مونتاج الفيلم، وأعدته بطريقة سردية أقوى وحافظت على المشهد الرئيسي. ولكن الفيلم ظلّ كلما عرض يحذف منه حوالى 20 دقيقة. عام 2001 جرت محاولة لعرض الفيلم في مهرجان الفيلم العربي قي روتردام، ووافق حينها مدير المؤسسة الجديد على طبع نسخة جديدة وعرضت فعلا في المهرجان كما هي. لكن الفيلم لم يعرض في الصالات ولم يوزع. اكتشف متحف الفن الحديث في نيويورك أن «اليازرلي» فيلم فني مختلف، وحصل اتفاق لعرضه اولا في مهرجان أبو ظبي. وعرض الفيلم، لكن مع الاسف لم تكن النسخة صالحة تماماً للعرض. وسيعرض الفيلم في نيويورك على أمل أن يحصل متحف الفن الحديث، بعدئذ، على نسخة جديدة من المؤسسة ويحتفظ بها وينظم لها عروضا في اوروبا ايضاً.
÷ ماذا عمّا أثاره قاسم حول حول كتابته لسيناريو الفيلم وإغفال ذكر اسمه؟
} القصة الحقيقية أنه قال لي إن لديه بعض الأفكار حول القصة فتركته يكتب، وفعلاً كتب بداية وفي امسية واحدة بعض الأشياء الجيدة. ولا أنفي أنني استفدت من بعض أفكاره. أما أن المؤسسة كلفته بكتابة النص وكتبه وما الى ذلك وأنها أرسلت له معي مالاً إلى بيروت، فهذا كله مختلق تماماً. لا أريد أن أثير الموضوع فهو صديقي، لكنه يكتب من الذاكرة، والشيء الوحيد الصحيح في حكايته أنني أهديته بالفعل قلماً. أنا آمل أن يقول حميد مرعي، مدير المؤسسة العامة للسينما آنذاك، رأيه حينما سيقرأ ما كتب حوله. حصل بعد ذلك أن كتبت المعالجة وطلب مني حنا مينه إضافة بعض المشاهد وأضفتها بالفعل، غير أن الفيلم لم يعجب حنا مينه، فمشاهد كثيرة في الفيلم هي من طفولتي، ولم يجدها من طفولته ولم يحبها. أما الحلول السردية والبصرية في الفيلم فأنا طبعا من ابتكرها. ثم إنه يقول إنني أحمل الفيلم وأدور به على المهرجانات في وقت، والكل يعلم، بقي الفيلم أكثر من 35 سنة موقوفاً عن العرض.
÷ باعتبارك أحد المشتغلين في السينما السورية، كيف تنظر إليها اليوم؟
} هناك أسماء مهمة في السينما السورية من دون شك. لكن مشكلة الافلام دائماً توجد على الورق، ليس بالضرورة أن يكتب المخرج النص، فالكتابة عملية أدبية فنية، وكل النواقص فيها تنتقل إلى الفيلم. إذا عدت أفلام الكبار لن تجد أن المخرج هو الكاتب بالضرورة. دائماً هناك الدراماتورغ الذي يشتغل على النص. هذا الأمر لا يجري الاشتغال عليه في السينما السورية. المخرج اختصاص، وكتابة السيناريو اختصاص آخر. من هنا تجري محاولة تفليم الروايات والاعتماد عليها في كتابة النص، ريمون بطرس في «حسيبة» رواية خيري الذهبي، أو سمير ذكرى في فيلمه «حراس الصمت» عن رواية لغادة السمان، هذه إحدى الحلول لكن تبقى مسألة النص السينمائي هي مشكل الفيلم العربي عموماً.
يمكن القول باطمئنان إننا لم ندخل بعد في السينما العالمية ولم نخرج من المحلية. لم ننجز هذه المهمة، علينا أن نفكر بمن نخاطب، وما هو طموحنا، فبالتأكيد أننا لا نعمل سينما كي نعرض مرة أو مرتين في المهرجانات وحسب.
راشد عيسى
المصدر: السفير


إضافة تعليق جديد