المثقفون تحت الاحتلال إما المقاومة وإما العمالة
ما أن أسدلت الحرب العالمية الثانية ستائرها، حتى خرج الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، بعدما انفلت من القيود النازية، ليقول إنه لم يكن أمام الأدباء والفنانين الفرنسيين، في ظل الاحتلال النازي، سوى خيارين: إما التعامل مع العدو أو المقاومة. في طبيعة الحال، أكد سارتر أنه اختار الاحتمال الثاني، «فمهمتنا كانت أن نقول للفرنسيين إن الألمان لن يحكمونا فعلياً مهما طالت مدة إقامتهم».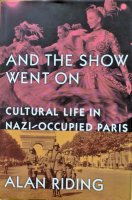
في الواقع، لم يكن موقف سارتر – كما الكثير من المثقفين والأدباء الفرنسيين - خلال فترة الاحتلال، بطولياً كما ادعى، لكنه في الوقت عينه لم يكن عميلاً؛ كما يقول الناقد آلان رايدينغ، الذي أنجز أخيراً كتاب «واستمر العرض: الحياة الثقافية في باريس خلال الاحتلال النازي» (الصادر عن دار نوبف).
< يورد الكاتب أن بعض المقربين من سارتر نظروا إلى بعض مسرحياته، ومنها مسرحية «لا مخرج»، بصفتها تعبيراً احتجاجياً غير مباشر ضد الاحتلال. لكن المفارقة كانت أن كل مسرحيات سارتر مرت عبر أجهزة الرقابة الألمانية من دون أي مشكلة تذكر، كما أن الضباط الألمان لطالما كانوا سعداء بحضور عروض الافتتاح الأولى لمسرحياته، والحفلات التي تعقبها.
في مقابلة أجريت معه بعد نحو ثلاثين عاماً، كان سارتر أكثر وضوحاً وشفافية حيال موقفه من النازيين، حين قال: «في عام 1940 كنا جميعاً نخشى الموت والمعاناة من أجل قضية لا نؤمن بها. في ذلك الوقت، كانت فرنسا مثيرة للاشمئزاز جراء تفشي الفساد والعنصرية وانعدام الكفاءة ومعاداة السامية. كان الأغنياء يديرون البلاد من أجل الأغنياء فقط. ولم يكن هناك من يرغب بالموت في سبيل فرنسا كهذه. حسناً، إلى أن أدركنا أن النازيين كانوا خياراً أسوأ».
يرى رايدينغ، أنّ في أوروبا ما بعد الحرب، ظلت ذكريات الاحتلال النازي ماثلة بقوة في أذهان الجميع. وبوحي من تصريح سارتر، صنف الناس عادة في خانة الخير والشر: المقاومون والعملاء. ومجرد اشاعة بسيطة عن علاقة أحدهم بالنازيين كانت تكفي لعزله اجتماعياً واقتصادياً. استغرق الأمر بضعة عقود لكي تتلاشى هذه الصورة المزيفة، وليدرك الناس أن الفصل بين الأخيار والأشرار أمر نسبي. والحقيقة أن مواقف تخاذلية سجلت خلال الاحتلال النازي، وتم تضخيم المقاومة الفرنسية في مخيلة الكثيرين، على رغم أنها لم تكن واسعة النطاق ولا كثيفة العضوية كما يراد لها استرجاعياً أن تكون. أقصى سبل للمقاومة تبناها بعض المثقفين وتجسدت في «المقاومة السلبية»؛ أي تفادي التعامل مع الاحتلال.
المقاومة والتعامل
ووفق الكاتب، رفض الكثير من المثقفين والمفكرين الفرنسيين الطروحات النازية، لكنهم اختاروا عدم المقاومة أو التعامل لأسباب متفاوتة. ربما تعود جذور هذا الحياد أو «التعاون» مع الألمان إلى الثورة الفرنسية نفسها، إذ لطالما مقت اليمين الفرنسي المتشدد فكرة انبثاق الجمهورية الفرنسية العلمانية ورغب بشدة في العودة إلى سلطة الكنيسة الكاثوليكية. كما أن البعض كان ينفر من كل ما له علاقة بالبريطانيين، فما بالك بالنفوذ الأميركي الذي يلوح في الأفق. ناهيك عن أن فرنسا لم تكن قد تعافت تماماً من تداعيات الحرب العالمية الأولى، وأي مواجهة جديدة مع ألمانيا قد تعني مجزرة أخرى في فردان وآيسن. لذا عندما دعا المارشال بيتان إلى السلام مع ألمانيا عام 1940، وأسس دولة فيشي، قوبلت خطوته بارتياح كبير. على الأقل سيتم تجنيب فرنسا التضحية بمليون قتيل. لكن الواقع كان مغايراً ومريراً، فقد خسر الفرنسيون 100 ألف قتيل عام 1940، والحقيقة البشعة كانت ان مواطنين فرنسيين كثراً لم يملكوا الحافز للدفاع عن وطنهم: المنتمون إلى اليسار، ومن بينهم سارتر، كانوا مستائين من الفساد والبرجوازية والرجعية المطلقة اليد في بلادهم فتخلفوا عن حمل السلاح والمقاومة، والفاشيون مثل روبرت براسيلاك كانوا ممتنين للألمان لكونهم أنهوا سطوة اليسار واليهود والليبراليين والماسونيين. ومن تبقى من خارج الفئتين، كان يؤمن بأن الجمهورية الثالثة في فرنسا تعاني من الفساد والسرقات والفضائح.
يشير رايدينغ إلى بعض الكتاب والفلاسفة الفرنسيين من أمثال جان بولان ممن كانوا فاعلين في المقاومة، لكن القسم الأكبر من النخبة الثقافية وفي مقدمهم جان بول سارتر، سيمون دو بوفوار، آندريه جيد، بول كلوديل، وألبير كامو، لم تكن مواقفهم لافتة، وانحصرت مقاومتهم في بعض الشعارات واللقاءات الأدبية في مقاهي السان جيرمان في باريس. أما معظم الأدباء الذين تعاملوا مع النازيين فكانوا من الدرجة الثانية ما عدا بيار درو لا روشيل، آبل بونارد، وبراسيلاك. مع ذلك، يشدد الكاتب على أنه سيكون من السذاجة الربط بين الإبداع والولاء للوطن، أو الاعتقاد بأن التعامل مع العدو هو مؤشر على تدني الموهبة أو المقدرة الفنية والأدبية، إذ كان هناك فنانون على مستوى راق تعاملوا مع الألمان ومنهم الراقص سيرج ليفار، وعازف البيانو اللامع ألفرد كورتو.
السؤال المحوري الذي يطرحه الكتاب هو: هل يجب تحميل المثقفين والأدباء والفنانين مسؤولية أكبر أو أكثر مما يتحملون؟ وهل من المشروع أن يتوقع منهم الناس مواقف بطولية لمجرد أنهم شخصيات عامة ومعروفة؟
يركز الكتاب أيضاً على حقيقة أن هتلر ووزير الدعاية النازي جوزف غوبلز كانا يريدان لباريس أن تبقى عاصمة ثقافية، لكن ما أراده الألمان بالفعــل هو الترويج لنموذج ألمانيا الثقافي على أنه النموذج المثالي، وتقليــص الثقافة الفرنسية ومسخها إلى صورة كاريكاتورية لا أكثر عبر المسرحيات الكوميدية السطحية، والفتيات الراقصات في الكباريهات، والأفلام الترفيهية التافهة من دون مغزى. في هذا الإطار، برز قول لغوبلز: «أعطيت تعليمات واضحة بأن الأفلام الفرنسية يجب أن تكون خفيفة وسطحية وربما هابطة إن أمكن».
البروباغندا الثقافية
لكن هذه السياسة لم تكن فاعلة، إذ حرص الفنانون الفرنسيون على ألا تهبط ثقافتهم إلى مستويات متدنية، وتعاضدوا معاً في وجه آلة البروباغندا الثقافية الألمانية وإن بالفكر.
يشير رايدينغ إلى أن الرسامين والكتاب الكبار ومنهم بيكاسو وهنري ماتيس وفرنسيس بولنك وسارتر ودو بوفوار ركزوا على أعمالهم في تلك الفترة فأنتجوا أبرزها وأشدها تأثيراً. وعندما عرض على ماتيس تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة عام 1940، كما فعل الكثير من المثقفين في حينها، رفضها تماماً قائلاً: «إذا هرب كل من له قيمة، فماذا سيبقى من فرنسا؟». مع ذلك، أوجد المسؤولون الألمان في فرنسا مثل أوتو أبيتز ما يشبه المنطقة الرمادية، فسمحوا للفنانين والكتاب الفرنسيين «المتعاونين» معهم بالعمل والتحرك من دون أن يشعروا بأنهم باعوا أرواحهم للألمان. لذلك كان في الإمكان إنتاج فن على مستوى راق في فرنسا في ظل الاحتلال النازي، بطريقة قد تكون مستحيلة في وارسو أو برلين. وربما يعود الفضل في ذلك إلى فن الإغراء الألماني. هذا الأمر لم يزعج الكثير من الفرنسيين، وسرعان ما تحول بعض الناشرين، وأصحاب المعارض الفنية، والأدباء، ومنتجي المسرحيات، إلى متعاونين. في الواقع قد يبدو مفاجئاً أن الألمان في باريس كانوا أكثر تسامحاً لجهة الرقابة من نظرائهـم في حكومة فيشي. وعلى سبيل المثل، فإن مسرحية «الآلة الكاتبة» لجان كوكتو حظرها الفيشيون لكونها «غير أخلاقية»، بينما وافق الألمان على عرضها بذريعة «الحرية الفنية». كما أقام الألمان حفلات كثيرة للترويج للتقارب الألماني-الفرنسي، قدموا خلالها النبيذ والطعام الجيد وهي امتيازات كانت نادرة في باريس في ذلك الوقت.
كانت المناطق الرمادية أكثر من مغرية لبعضهم، موريس شوفالييه مثلاً لم يكن لديه مانع من العزف والغناء لراديو باريس، الذي يعد آلة الدعاية الأولى لدى النازيين، كما أن الراقص سيرج ليفار قام بعروض عدة في السفارة الألمانية، حتى أنه زار برلين والتقى هتلر.
في وقت لاحق، قتل الكثير من المثقفين في حملات التطهير السياسية التي قام بها رجال المقاومة السرية على طريقة حكومة فيشي التي سبق أن عارضوها. وقد انتحر دريو لا روشيل قبل أن تتم محاكمته. أما براسيلاك فحكم عليه بالإعدام عام 1945.
ومن ثم عمل الكثير من الأدباء ومنهم كامو من أجل تحقيق المصالحة والغفران. وسرعان ما أدرك ديغول أن البلاد لا تتحمل حرباً أهلية، وأوقف عمليات التطهير. حتى أن بعضهم انتقد التحامل على الأدباء والمثقفين الذين تعاملوا مع الألمان.
وكتب الصحافي جان غالتييه بواسيير، مؤسس صحيفة «لوكانار أنشينيه»، يقول بوجوب عدم التفريق بين من حمل قلماً وبين العامل العادي الذي ساعد الألمان في صنع معدّاتهم، وقال: «هل هناك من تعرض للعمال في مصنع رينو لأنهم صنعوا السيارات للبيشمارك؟ ألم تكن الدبابات أكثر نفعاً للنازيين من مقال ينشر في لو بوتي باريزيان؟».
يخلص آلان رايدينغ في كتابه المذهل إلى «أن عظمة الأدباء الفرنسيين قد تهاوت في تلك الفترة، والسبب هو أنهم هم أنفسهم لم يعودوا مؤمنين بأن الأفكار وحدها قد تحل مشكلات الحياة».
هناء عريان
المصدر: الحياة


إضافة تعليق جديد