في رحيل سركون بولص
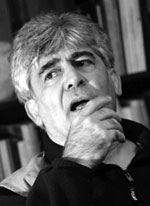 سركون بولص أنا من باع حياته... وجسدي لم يعد يتبعني
سركون بولص أنا من باع حياته... وجسدي لم يعد يتبعني
لقد فعلها أخيراً! مضى فجر أمس، بخفّة كما عاش.
سركون بولص الذي صرعه الوهن عن 63 عاماً، يوارى الثرى في برلين على مقربة من مواطنه المسرحي عوني كرومي. إنّه الشاعر العراقي الأكثر شفافيّة، كتب كما عاش، بلا ظهر ولا قبيلة ولا مريدين
رحل سركون بولص. لعل الخبر فيه قدر لا يُستهان به من المفارقة. إذ لا نعرف إن كان سركون مقيماً بيننا بكامل حضوره الشعري، حتى نقول ببساطة إنّه رحل. ألم يكن هذا الشاعر راحلاً، بالمعنى الجغرافي، حين ترك مدينته الأولى كركوك إلى سان فرانسيسكو ملبياً نداء الشعر الغامض والسحري؟
ألم يكن راحلاً، أو بالأحرى مرحّلاً، بالمعنى النقدي، عن حياتنا الثقافية التي يقوم جزء كبير منها على النميمة والدسائس، والتي غالباً ما يلعب فيها الوجود الشخصي للشاعر دوراً أساسياًً في الاهتمام به ومتابعة تجربته. ثقافتنا ساحة للعلاقات الشخصية، ولا تتذكر من هم بعيدون إلا في المناسبات. على الشاعر أن يحضر فيها مع كتابه. بغير هذه الطريقة لن تكون له عزوة. سركون بولص كان بعيداً باستمرار. لم يكن لديه وكلاء وممثلون شخصيون كي يديروا «أعماله» الشعرية هنا. بهذا المعنى، كان غياب سركون بولص مصدر راحة لكسلنا النقدي. لم يكن موجوداً بيننا ليحرجنا، بشخصه على الأقل، إن لم يكن بشعريته الفذة التي يصعب علينا تجنب تأثيرها.
في حالة سركون، ثمة دوماً أسباب إضافية للحزن. فهذا الشاعر المتفرد عاش بلا ظهر، بلا قبيلة، بلا مريدين. باستثناء من تعرفوا إلى الأحشاء الحقيقية لتجربته الشديدة الخصوصية ـــــ وهم قلّة بالطبع ـــــ لم يتسنَ لصاحب «الوصول إلى مدينة أين» أن ينتشر ويُدرس نقدياً ويُحدد أثره الشعري، سواء بين مجايليه أو بين من الأجيال التي جاءت بعده. الشعر عصبيّات، وسركون بولص لم يكن يملك ما يُديم ذكره ويدافع عن موطئ قصيدته الراسخ والمتميز. لقد وهب حياته للشعر. لم يفعل شيئاً آخر تقريباً. لكنه في الوقت نفسه، وكأي شاعر حقيقي، لم يسعَ إلى الأضواء. لم يخطط لصناعة شهرة أو صيت مبالغ به. لم يسأل عما كانت تفعله نصوصه بقرائها. كنا نعرف أنه مريض بالشعر، قبل أن يُصاب بذاك المرض الفتّاك الذي يُسرع بصاحبه إلى الموت.
كان سركون بولص شاعراً حقيقياً إلى حد أنه أهمل أن يتقصّى ما يتسرّب من شعره إلى نصوص الآخرين. لم يكترث بأن يكون هؤلاء مدينين له، ولم يطرق أبوابهم يوماً مطالباً بما له في ذمّتهم. منذ بداياته المبكرة، حين كان واحداً من «جماعة كركوك»، كانت نصوصه تأتينا من حيث لا نتوقع. كان شاعر قصيدة نثر ولكن على حدة. وحين صارت قصيدة النثر مشاعاً ظلت قصيدته محتفظة بقوة المفاجأة.
ما إن نقرأ مستهل أي عمل من أعماله حتى ندرك أننا مدعوون للسير في طريق فرعية، ضيقة ووعرة، ولا يسلكها الشعراء عادة. لعل جزءاً من فرادة سركون بولص تكمن في أنه أراد أن يرفع النثر نفسه إلى مستوى الشعر، لا أن يستخرج قصيدة من هذا النثر. أن يحقق النثر حضوره النصي من دون سعيه إلى أن يكون شعراً. باستثناء تجارب نادرة، وقع أغلب شعر النثر العربي في مصيدة أن شاعر قصيدة النثر مطالب بإثبات «شعرية» هذه القصيدة، مستسلمين لفكرة وهمية تمنح الشعر مقاماً أرفع من النثر، بينما كان طموح تلك الأقلية النادرة هو إثبات «نثرية» ما يكتبونه.
وهب سركون بولص كل شيء للشعر، بحيث يصعب علينا أن نفرّق بين أن يكون قد فارق الحياة الآن أم فارق الشعر.
بنبرته المادية ومفرداته الملموسة والحسية المنتمية إلى المعجم الخشن للنثر، بلغته المتخلية عن البلاغة ومعظم الأسلحة والذخائر التقليدية للشعر، أراد صاحب «الأول والتالي» أن يتفرغ لممارسة شعرية مختلفة. ولهذا كانت أعماله زاخرة بما هو غريب ومدهش وبعيد عن المتناول. كأن جملة سركون الشعرية كانت من اختراعه. خُلقت معه، والأرجح أنها ستُدفن معه. غالباً ما يبدأ قصيدته بجملة لا تسهّل على القارئ أن يعرف كيف سيكملها، وكيف، بالتالي، ستنشأ الاستعارة الشعرية التي يطاردها في خياله. جملة سركون بولص وصوره الشعرية ونثريته الفاتنة، كل ذلك هو ماركات مسجلة باسمه. حين نقرأه لا يذكِّرنا سوى بنفسه.
تعب جسد سركون بولص وخذله. كان خياله الخالد سابقاً لجسده الفاني. لقد أدرك هذا مبكراً، فكتب: «أنا من باع حياته ليشتري عينين وفيتين / أتعبني ما عرفتُ مقدماً / وجسدي لم يعد يتبعني». ولكي تكتمل صورة الشاعر فيه، «تواطأ» مع الذين أهملوا شعره، فأهمله هو أيضاً. أصدر كتابه الأول بعد أكثر من عشرين عاماً على حضوره القوي والمباغت على صفحات مجلتَي «شعر» و«مواقف» في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي. كتب كثيراً ولم ينشر إلا القليل.
مستشهداً بجيرترود ستاين، وفي كلمة مخصصة ليوم الشعر العالمي، كتب سركون بولص قبل أعوام، أن على الكاتب أن يكون له وطنان... ذاك الذي ينتمي إليه والآخر الذي يعيش فيه فعلاً. لعل صاحب «حامل الفانوس في ليل الذئاب» كان يدافع عن خياره المبكر بمغادرة مسقط رأسه، واللحاق بالشعر الذي قاده إلى بيروت ثم سان فرانسيسكو ثم برلين. الواقع أنّ هذا المسار الواقعي يُخفي السيرة الحقيقية لهذا الشاعر الذي كان يسعى إلى الحصول على إقامة دائمة في أرض الشعر.
الأرجح أن فكرة أن يكون للشاعر وطنان هي التي جعلته يكتب: «أنا في النهار رجل عادي / يؤدي واجباته العادية دون أن يشتكي / كأي خروف في القطيع / لكنني في الليل / نسرٌ يعتلي الهضبة / وفريستي ترتاح تحت مخالبي».
حسين بن حمزة
شاعر من دون سلالة
بعيداً من «جماعة كركوك» وتأثيراتها الستينية، سوف تصنع قصيدة سركون بولص حديقتها السرّية وثمارها اللاذعة.
شاعر من دون سلالة، يقف وحيداً بلا ضجيج إيديولوجي، لكنّه وصل باكراً إلى الوليمة عبر المنافي، من بغداد إلى بيروت... إلى سان فرانسيسكو. الآشوري الأعزل بدا مثل طائر غريب على شجرة الشعر. يكتب فاجعته الشخصية وجحيمه السرّي، بأقل قدر من الندم، فهو في نهاية المطاف يعيش لحسابه الخاص. لذلك ذهبت قصيدته باكراً إلى اختبار الذات بهدم متواصل للحميمي والعابر، والإنصات العميق إلى المرئي، لتنشأ مشهدية باذخة من دون مرجعيات صريحة، عدا إشراقات الداخل المحتدمة بالعويل «في صدري مائدة محطّمة، سكين شاردة تقود إليها ضيوفي».
في شعر سركون بولص، لن تهتدي إلى نقطة علّام ثابتة، ذلك أنّ قصيدته مثقلة بالتاريخ الشخصي والمنفى، وانخراط صريح في حمأة العالم واحتجاج علني ضد الهلاك عبر مشهد أو صوت أو أغنية. هذا السندباد الشعري صنع خريطة سرّية لمشاغله الشعرية والجمالية، وبات صعباً أن تلمس آثار خطواته. ألم يقل ذات مرة «هكذا صارت حياتي أشبه بجغرافيا لا يمكن تفسيرها». هي كذلك فعلاً. قصيدة وربما حياة لا تركن إلى سياج، فالقصيدة كما يقول، قد تضيع، إذا لم تجد الخيط الخفيّ و«الراوي لن يعرف القصة».
لكن ألم يكتب صاحب «حامل الفانوس في ليل الذئاب» طوال الوقت مرثيته الشخصية، منذ هجرته الأولى، فليس للآشوري وطن سوى الشعر «تطفح عزلتي مثل جرّة تحت حنفية الصمت. تقدم أيها الظل. اُدخل إلى بيتي وانهب ما تشاء».
حامل الفانوس كان يتلمّس طريقه في العتمة في تجربة عبور مستمرة، وربما لهذا السبب، لم تركن قصيدته إلى إطار أو سلالة، فالزمن هو من يصنع أقدار الشاعر في سفر دائم من وإلى «إيثاكا» للعثور عليها من جديد.
لا يشبه سركون بولص أحداً، لذلك ظل نصه عابراً للأجيال في ذاتيته وحسيته ومشهديته وطزاجته. فانوس في ليل الشعر العربي، تتكئ إلى ظلاله الأجيال المتعاقبة، وتتفق على فرادته من دون سجال، بعيداً من الجوقة. إذ لطالما أنشد الأغنية التي لم يكتبها أحد. أغنية الروح المتمردة في عزلتها الاضطرارية. هكذا «تذهب الأغاني، وتجيء المراثي. لا شيء منذ آدم غير ملحمة التراب».
خليل صويلح
وصلت أخيراً يا صديقي
يا صديقي سركون لقد وصلت أخيراً الى المدينة التي بحثت عنها طويلاً. وصلت أخيراً يا صديقي الى مدينة «أين». من الحبانية الى كركوك الى بغداد الى بيروت الى سان فرانسيسكو الى مدن كثيرة بحثاً عن مدينة لا تجدها، حتى أطلّت عليك أخيراً في مستشفى في برلين! مدينة الموت، هذه إذاً هي التي كنت تبحث عنها. هذه، ولا شيء آخر، التي نبحث عنها جميعاً. هذه فقط هي ما يبحث عنه الشعر.
لا تزال لديّ رسالتان منك أرسلتهما إلي من سان فرانسيسكو الى شبطين عام 1971. تقول في الأولى: «لم أنتظر الليل بل تقدمت نحوه وأنا أعرف عدوّي وبلا درع أو شهادة أو تردّد... ومن حين إلى حين، وجهي المعلّق في مرآة محاكمة. وأنا دائماً قاضي هذا العالم». وتقول في الثانية: « أكتب كرجل أنذروه بالساعة الأخيرة. كل ما أفعله لا يملك ذلك الرنين الحقيقي أو الحرارة الإلهية إلا عندما تخرج من أطراف أصابعي قصيدة تجعلني أستحق نهاري»... وقبل يومين، حين هاتفتك وأنت على فراش الموت، كان صوتك متهدجاً لكن بقيت فيه نبرة «قضاة العالم».
وما تركته يا سركون من قصائد لم يجعلك أنت وحدك تستحق نهارك، إنما يجعل كل قرائك يستحقون نهاراتهم.
اعذرني يا سركون، فليس عندي كلام أمام موتك.
الآن وصلني نبأ صمتك الأبدي، وما عدت أملك غير الصمت.
وديع سعادة
كيف ندفنك الآن في قصيدة؟
«في الفجر الكابي غادرَنا سركون. يسهم خالد المعالي ومؤيد الراوي وبعض الأصدقاء في إجراء متطلبات الوداع. كأننا كنا نودّع معاً شاعراً وإنساناً كما قالت إحدى معارف سركون في برلين»
«البرقيّة» الإلكترونيّة الآتية من صقيع الشمال، تختصر الموقف. عراقيّ آخر يمضي وحيداً في غربته. شاعر ليس كالآخرين. من لندن صموئيل شمعون يردّد على الهاتف جملة كتبها أدونيس لتكون مقدمة كتاب لسركون تصدره «بانيبال» بالإنكليزيّة: «إني أحبّك يا سركون». يحزم الصعلوك حقيبته. «لا بد لي من ملاقاته في برلين». في المدينة التي اصطفاها عاصمة أيّامه الأخيرة، تجمّعت بالأمس حفنة من الشعراء والكتاب التائهين حول جسد شاعر. على المرتبة تمددت أجمل سنوات التيه العراقي، وقصيدة النثر العربيّة. من «جماعة كركوك» هناك ومؤيد الراوي وفاضل العزاوي. الكل منشغل بمسألة مهمة. أين يُدفن الشاعر؟ في أي وطن؟ ذات ربيع كتب سركون بولص، تلبية لطلب قاسم حداد في اليوم العالمي للشعر، رسالة نشرها موقع «جهة الشعر»، يقول فيها إن الشاعر وطنه الثاني القصيدة. لكن كيف ندفنك الآن في قصيدة؟ أيها العراقي البعيد عن بغداد، أيها البيتنك البعيد عن سان فرانسيسكو؟
هل كان سركون يعرف، بحدسه المعهود، أنّ أيامه معدودة؟ قبل أسابيع أدخل العناية الفائقة في أحد مستشفيات برلين. ثم تحسنت صحّته، لكنّه غادر سريره مخالفاً قرار الأطباء. لا وقت لديه يضيعه في المستشفيات. كان يريد أن يرتشف ما بقي له من الكأس. «الآن فقط بدأت أعرف كتابة الشعر ــــ قال قبل أيام لصديق ـــ فمن أين أتاني هذا الوهن اللعين؟».
سركون بولص هو الشاعر الذي خفف القصيدة من جاذبيتها... شاعر عراقي خرج على الغنائيّة، راح يصيخ السمع الى موسيقى خفيّة طالعة من أعماق النثر. هوائي وخفيف ومسافر، تسكن الأماكن نصه والمدن والحكايات القديمة. فالنثر مخزن الذاكرة، ذاكرة الآخرين أيضاً. «تكمن المشكلة في كيفية أخذ المفردات القديمة ووضعها في محيط جديد» كتب ذات يوم، و«لهذا السبب قد يجد المرء أثناء الكتابة، في منتصف رحلته أو قرب نهايتها، أنه طوال الوقت كان يسافر صوب إيثاكا، وأنه إنما تركها من أجل العثور عليها من جديد». إيثاكا هي أيضاً «مدينة أين» التي يمم شطرها عمراً كاملاً... ولا نعرف إن كان قد وصلها. أم أنه يتركها لقرّائه يقصدونها عنه؟ الرحلة الطويلة حقاً كانت هادئة، خافتة رغم صخبها الداخلي: من «ريف» كركوك إلى مقاهي بغداد المزدحمة بأحلام الستينات، ومن سراب الحداثة في بيروت إلى «الوليمة العارية» التي دعاه إليها وليم بوروز ذات يوم. كنا نعتقد أن أميركا هي مأواه الأخير، حين أخذه العطش إلى أوروبا... «على الطريق» مجدداً، على خطى الوقت الهارب. «هكذا صارت حياتي، أشبهَ بجغرافيا/ لا يمكنُ تفسيرُها/ بالمواقع ِ والأماكن، وصوتُ أيّامي/ لم يعُد قابلاً للتبنّي/ من قِبَل ِ أزمنة الآخرين».
في الفترة الأخيرة تغيّر كلّ شيء. القلب ضعيف، والوجدان مثخن. والوطن الأول يشبه أحلام المراهقة المنسيّة في «سينما سندباد» المهدومة. والمرض الغامض قد لا يكون له ذكر في كتاب الطب، بل في مدوّنات القدماء وأساطير الملوك الآشوريين، وأحوال الشعراء الكبار. إنّه «وجع العصر». كان من المقرر أن يعود سركون إلى سان فرانسيسكو يوم السبت 27 الجاري. أجّل السفر أسبوعين، شيء ما كان يشّده إلى تلك المدينة. لعلّها أطياف «جمهوريّة فايمار» عشيّة الكابوس النازي، مدينة الكوبرا والباوهاوس والدادائيّة، أوتو ديكس وبيسكاتور وبريخت وكورت فايل... وعدد لا يحصى من خلانه. برلين هي فينيسيا (البندقيّة)، هنا أراد أن يموت، كما بروفيسور توماس مان. وحده وسط سحابة من دخان... عند مفترق الطرق بين عوالم وأزمنة متضاربة.
ملائكة برلين تسرّبت من فيلم فيم فندرز، أخذته بيده ومضت بعيداً. بعيداً... أبعد من العراق. Salut Beatnik !
بيار أبي صعب
الشاعرُ العراقيّ الوحيد
سركون بولص (1944 ــــ 2007)، يرحل في برلين...
في مستشفىً ببرلين.
في تمّوز، هذا العام، وفي الجنوب الفرنسيّ، في مهرجان لودَيف تحديداً، ألتقي سركون لقاءً غريباً.
كنتُ أعرفُ أنه في لودَيف، قادماً من لقاءٍ شعريّ بروتردام، لكني لم أجده في الأيام الأولى. انطلقتُ باحثاً عنه في الفنادق والمنازل، بلا جدوى. أنا أعرفُ أنه مريضٌ، وأنه بحاجةٍ إلى انتباه واهتمامٍ... لم «أعثرْ» عليه في هذه البلدة الصغيرة التي لا تصلحُ لأن تكون بوّابةً حتى لنفسها...
سألتُ عنه أصدقاء، فلم يجيبوا.
عجباً !
وفي صباحٍ باكرٍ. عند مخبزٍ يقدم قهوة صباحٍ. رأيتُ سركون جالساً على الرصيف. كنتُ مع أندريا. قبّلتُه: أين أنت؟
كان شاحباً، مرتجفاً من الوهَن، محتفظاً بدعابته: في الساعة الثالثة فجراً طردتْني مالكةُ نُزْلِ الورود. La Roseraie
كانت تصرخ مرتعبةً حين وجدتْني متمدداً على أريكةٍ في البهو. سهرتُ مع خيري منصور وغسان زقطان. هما ذهبا ليناما في غرفتَيهما. لا مجال لي للعودة إلى الغابة. قلتُ أنام قليلاً هنا حتى انبلاج الصبح. لكنّ السيدة جاءت...
سألتُه: عن أيّ غابةٍ تتحدّث؟ (ظننتُه يهذي). قال بطريقته: إي... الغابة التي اختاروا مسكني فيها. ليس في المسكن فراشٌ مجهّز. المكان مقطوع. هناك سيارة تصل إلى المكان مرةً واحدةً في اليوم!
أخبرتُه أنني بحثتُ عنه في كل فنادق المدينة ومنازلها.
قال إنه ليس في المدينة!
جلسنا معه على الرصيف.
فجأةً لمحتُ إحدى المسؤولات عن المهرجان تخرج من باب منزلها.
ابتدرتُها بالفرنسية: Il va mourir dans la rue…
سوف يموت في الشارع!
عواهرُ المهرجانات، يستمتعن، كالعادة، في غرفاتٍ عالية...
***
قلقي عليه ظلّ يلازمني.
حقاً، اشتركتُ معه، في جلسة حديثٍ مشتركة، أمام الجمهور، عن العراق، وكان رائعاً وراديكالياً كعادته، ذا موقفٍ مشرِّفٍ ضد الاحتلال، على خلاف معظم المثقفين العراقيين. أقول إن هذه الجلسة المشتركة التي بدا فيها أقرب إلى العافية، لم تخفِّفْ من قلقي عليه.
رأيتُه آخر مرةٍ، في منزل الوردِ التعيس، حيث جاء به أنطوان جوكي ومصوِّرُ سينما. قالا إنه سوف ينزل هنا (المهرجان أوشك أن ينتهي). ظلاّ يرهقانه بمقابلةٍ تافهةٍ، ثم أخذاه فجأةً إلى خارج منزل الوردِ. سألتُهما: أين تمضيان به؟ إنه مريض.
أجابا: هناك إجراءٌ رسميّ (توقيع أو ما إلى ذلك) ينبغي أن يستكمَل!
قلتُ لهما: إنه لا يستطيع السير. دعاه يستريح. نحن نعتني به.
قالا: لدينا سيارة!
انطلقت السيارةُ به، مبتعدةً عن منزل الورد.
في الصباح التالي غادرتُ لوديف إلى غير رجعةٍ.
***
قلقي عليه ظلّ يلازمني.
اتّصلتُ بفاضل العزاوي في برلين. ألححتُ عليه أن يتابع حالة سركون.
سركون في غُرَيفةِ مؤيد الراوي.
ثم اتصلتُ ثانيةً. قلت له إن سركون في المستشفى.
طمْأنني فاضل عليه.
لكني لم أطمَئِنّ.
***
هذا الصباح، ذهب خالد المعالي، يعوده، في المستشفى البرليني، ليجده ميتاً...
(التفصيل الأخير تلقّيتُه من صموئيل شمعون الآن...)
***
ذكرتُ أن سركون بولص هو الشاعر العراقيّ الوحيد...
قد يبدو التعبيرُ ملتبساً.
لكن الأمر، واضحٌ، لديّ.
سركون بولص لم يدخل الشعر إلا من باب الشعر الضيّق.
بدأ في مطلع الستينيات، مجهّزاً، مكتمل الأداة، مفاجِئاً وحكيماً في آن.
لم يكن لديه ذلك النزق (الضروريّ أحياناً) لشاعرٍ شابٍّ يقتحم الساحة.
سركون بولص لم يقتحم الساحة. لقد دخلَها هادئاً، نفيساً، محبّاً، غير متنافسٍ.
كان يسدي النصيحةَ، ويقدم أطروحة الثقافة الشعرية الرصينة، مقابل الخصومةِ، والمشتبَكِ، والادّعاء.
لم يكن ليباهي بثقافته، وإن حُقّتْ له المباهاة.
هو يعتبرُ الشعرَ نتيجَ ثقافةٍ عميقةٍ وممارسةٍ ملموسةٍ.
سركون بولص يكره الادّعاء!
***
وأقول إنه الشاعرُ الوحيدُ...
هو لم يكن سياسياً بأيّ حالٍ.
لكنه أشجعُ كثيراً من الشعراء الكثارِ الذين استعانوا برافعة السياسة حين تَرْفعُ...
لكنهم هجروها حين اقتضت الخطر!
وقف ضدّ الاحتلال، ليس باعتباره سياسياً، إذ لم يكن سركون بولص، البتةَ، سياسياً.
وقفَ ضد الاحتلال، لأن الشاعر، بالضرورة، يقف ضد الاحتلال.
سُمُوُّ موقفِه
هو من سُمُوّ قصيدته.
***
لا أكاد أعرفُ ممّن مارسوا قصيدة النثرِ، شاعراً ألَمَّ بتعقيدات قصيدةِ النثرِ، ومسؤولياتها، مثل ما ألَمَّ سركون بولص. مدخلُهُ إليها مختلفٌ تماماً. إنه ليس المدخلَ الفرنكوفونيّ إلى النصّ المُنْبَتّ، في فترةٍ مظلمةٍ من حياة الشعر الفرنسيّ:
رامبو مقتلَعاً من متاريس الكومونة...
مدخلُهُ، المدّ الشعريّ الأميركيّ. مجدُ النصّ المتّصل.
أطروحةُ تظاهرةِ الطلبة، حيثُ القصيدةُ والقيثارُ والساحةُ العامّة.
قد لا يعرف الكثيرون أن سركون بولص كان يطوِّفُ مع فريقٍ، لإلقاء الشعر في البلدات الأميركية والقرى...
طبلٌ وقيثارٌ وهارمونيكا ...
***
قصيدتُه عن «السيد الأميركيّ» نشيدٌ للمقاومة الوطنية في العراق المحتلّ!
سعدي يوسف
لا تلتفت إلى الوراء... غادر!
«يُظهر ملاك إذا تبعته خسرتَ كل شيء، إلا إذا تبعته حتى النهاية» (س.ب)
تجد في بريدك الإلكتروني جملةً واحدةً بالإنكليزيّة: «سركون بولص مات اليوم». الخبر لم يستدع توضيحاً من المرسِل كأنّه يعرف أن بقيته عندك بالضرورة. تفتح الباب وتخرج بملابس النوم إلى شارع خال: شمس خريفية تبدو مقتصدة في مشاعرها تقلّب المشهد في ظهيرة يوم أحد عادي. («كأن الحياة يوم أحد».. تفشل في تذكّر الشاعر الذي كتبها) تستند إلى طرف المدخل الحجري فتجده دافئاً. تقترب أكثر من الحجر وتفكّر في أنك تحتضنه وأن لا ضير في ذلك.
وقتها تفهم أنّ جملة Sarkoun boulos died today قد أشعرتك بالبرد.
سركون شاعر مغامرة مفرد تتضاعف أهميته في الثقافة العربية حيث مغامرات الشعراء تكون غالباً على الورق. كأن الكتابة شيء والحياة شيء آخر. لقد كانت أمثولته الكبيرة والبسيطة أنّ الكتابة والحياة شيء واحد وأنّ المغامرة الفنية تتسع باتساع مغامرة العيش. انظروا إلى الشعراء «المستقرين» الذين تزوجوا وأنجبوا وصار لهم أحفاد، «عمّروا» بيوتاً، واستثمروا و«صعدوا» مراتب النجاح. انظروا إلى الذين دبكوا في أعراس أولادهم وبناتهم. إلى الشعراء الذين يأكلون البطيخ الذي تشقّحه زوجاتهم في الصيف، و«القطائف» وسط العائلة وهم يشاهدون «باب الحارة» في شهر رمضان. إلى آكلي المكسّرات أمام قنوات فضائية تبث من خيام مكيفة تنطح سماء الخليج.
«سركون بولص مات... اليوم» هو أحد الأيام النادرة التي استيقظتَ فيها مبكراً. إذ قلّما صرتَ ترى الشمس، فأنتَ منذ سنوات تنام في النهار وتستيقظ في الليل. منذ سنوات تتنازل عن كل ما هو نهاري بتسليم قدري وتكسب كل ما هو ليلي بغير اكتراث. مكتسبات الليل لم تعد أكثر من مساحة محيّرة بين الميلانكوليا وشحنات من الغضب السياسي كدستَها مؤخراً تكفي لتفجير ثلاث دول ـــــ من تلك «الدول» التي تبدو «فكرة الهرب» أعلى فكرة تداعب خيال مواطنيها. غضب مدروس ومدوزن توجهه نحو زمن نشاز هو زمن الاحتلال للبلد الذي بت تشعر بأنّك لا تستطيع أن تتركه؛ لأنّ تركه يشبه الهرب من ساحة معركة. (أي معركة يا دونكي ــــ شوت؟).. الهرب قد يكون فعل الحرية الوحيد الممكن وقد يكون مجرد تخاذل؟ لا تملك إجابة.
تغضب لأنّ تحذير سركون وصلك في إحدى قصائده لكنك أهملت تلك «الوصية» التي قرأتها قبل خمس سنوات عند مفترق طرق وجودي: «قال لي: أنصحك أن لا تؤخر الأمر. لا تلتفت إلى الوراء. غادر./ هذه النقطة في الزمن، هذه البقعة في الأرض، هذا الحاضر الذي تستيقظ فيه: غادر./أنصحك أن تترك هذه الجثة وشأنها لأنها ماتت بل بدأت تتعفّنُ منذ مدة/ ولن يفيدها الآن لا شانيل رقم 5 ولا باكورابان..»
ولكنك بقيت تدور حولها كالجرو رافضاً أن تصدق. تتبين في داخلك غضباً ذاتياً خاصاً على الاحتلال هذه المرة. تفكّر في أن المذكور قد منعك من الذهاب في المغامرة إلى أقصاها كما حسبت دائماً أن شاعراً مثل سركون قد فعل. مغامرة «أن لا يكون لنا أهل أن لا يتعرف علينا أحد» كما يصفها مغامر آخر هو نوري الجراح. مغامرة أن يموت الشاعر بلا ورثة.
تفكّر في أنّ هذا كان خيارهم منذ البداية... فلماذا نستوقفهم ونتعرف عليهم وندلي بشهادات؟ الأحرى أن نسهر عند أكلة البطيخ والقطائف الذين «ثمّروا» و«عمّروا»! الذين سيتحدثون الليلة بإعجاب ــــ أمام أصهارهم ــــ عن موت شاعر يدعى سركون بولص!
نجوان درويش
مات «شاحذ السكاكين»
رفض سركون بولص مرضه منذ أن أحسّ به. تشمّع الكبد جرّاء نظرة الشاعر إلى الكون: لقد كان يرى كل شيء في وحدة الوجود تشتغل على هدم بنية الشاعر لا تأسيسه. وغالباً ما كان يقول: الكون يستمد جدليته بموت الشاعر .
لقد كان ضيفاً عند صديقه الشاعر مؤيد الراوي في برلين حين ساءت حاله الصحية، فخضع لفحوص عدة أُدخل على إثرها المستشفى. وكان وهو على سرير المرض يحضّر ديوانه الأخير باللغة الإنكليزية «شاحذ السكاكين» (Knives bounder). وقد انتابه فرح عارم حين عرف قبل وفاته بيومين، أنّ أدونيس انتهى من كتابة مقدمة الديوان باللغة الإنكليزية.
وخلال «معرض فرانكفورت للكتاب»، كان سركون يتعافى ويتابع الحياة بمتعة بادية. وكان قد حجز بعد ذلك على الطائرة المتوجهة إلى سان فرانسيسكو في 27 من الشهر الجاري. لكنّه فاجأ الجميع بتداعي حاله الصحية مساء الأحد الماضي، فنُقل على عجل إلى مستشفى «اندكة» وسط برلين. وعند الفجر، أسلم الروح إلى الرب الذي عرف سركون طفلاً واختار طريقه وهو طفل، يحمل حنو الشاعر وبكاء روحه على عالم يتداعى.
واليوم، يقام القداس على روح سركون في الكنيسة الأشورية غرب برلين، حيث سيحضر الشعراء مؤيد الراوي وفاضل العزاوي وخالد المعالي وحسين الموزاني وصموئيل شمعون، الذي وصل من لندن للتو إلى برلين. وسيدفن في مقبرة برلين القديمة بالقرب من صديقه المسرحي العراقي عوني كرومي، فيما لن تتمكّن عائلته المكوّنة من أخته وأخيه اللذين يقيمان في سان فرانسيسكو من حضور الجنازة.
وبعد مناقشات، اختار أصدقاؤه أن يُدفن في برلين... المدينة التي أحبّ.
فاروق سلوم
سيرة
أبصر النور في العام 1944، وعاش حتى الثالثة عشرة في الحبانية (800 كلم غرب بغداد) الزاخرة بالمياه. بعدها انتقل الى كركوك، وهنا بدأ كتابة الشعر. في العام 1961 نشر يوسف الخال قصائده في مجلة «شعر». وبعدها بخمس سنوات سيأتي إلى بيروت سيراً على الأقدام، عبر الصحراء وبلا جواز سفر. هنا قصد المكتبة الأميركية، طالباً أعمال آلن غينسبرغ وجاك كرواك وآخرين، وأعد ملفاً عنهم في «شعر». في المدينة التي كانت تعرف نهضة ثقافية، انكبّ على الترجمة، قبل أن يستأنف ترحاله. هذه المرّة ستكون وجهته الولايات المتحدة (1969)، وفي سان فرانسيسكو سيلتقي جماعة الـ«بيتنيكس» ويعقد صداقات معهم. ديوانه الأول «الوصول إلى مدينة أين» (1985) يعكس بوضوح تلك المرحلة البوهيميّة من حياته. مجموعات الشعرية الأخرى هي «الحياة قرب الأكروبول» (1988)، «الأول والتالي» (1992)، «حامل الفانوس في ليل الذئاب» (1996)، «إذا كنت نائماً في مركب نوح» (1998). وصدرت له مختارات شعرية مترجمة بعنوان «رقائم لروح الكون»، وسيرة ذاتية بعنوان «شهود على الضفاف» ومختارات قصصية نُشرت بالعربية والألمانية بعنوان «غرفة مهجورة».
- لا يمكن استعادة مسيرة سركون بولص من دون التوقف عند «جماعة كركوك». لقد ضمت هذه الجماعة أكثر تجارب الشعر العراقي الستيني طليعيةً: سركون بولص وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي وجان دمو وصلاح فائق... معظم هؤلاء كانوا يتقنون اللغة الإنكليزية، فاطلعوا على التجارب الغربية بوصفها مؤثراً ضرورياً في صنع النسخة العربية من الحداثة وقصيدة النثر. ولعل الاطلاع المبكر على الشعر الأميركي والتأثر به تدخّلا في تكوين نبرة سركون الشعرية الذي رأى أنّ «الترجمة تجعل جميع اللغات والكتابات تتداخل وتتلاحم لتخلق شيئاً جديداً»، ناصحاً «كل شاعر بأن يعرف لغة أخرى وأن يحاول الترجمة حتى لو كان ذلك من أجل لذته الخاصة».
المصدر: الأخبار
عاش كثيراً في وقت قليل
التقينا في جرش ذات يوم. في ركن الفندق كانت هالة ذكورية متوهجة، وجه وسيم مصفح ضد كل القاعدين، وجسد يحاول ان يسترخي، لا يعرف. تقدمت الى سركون بولس متسلحة بقراءتي شعره، فلم يفلح الامر. لم يعنه انني احفظ بعض قصائده، غير انه افسح لي مطرحاً على الكنبة الجلدية، دعاني الى الجلوس، ننتظر معا أخاه وبعض اقربائه يأتون قريبا لاصطحابه في دعوة غذاء. سألني مرافقته لكي اجنبه «الفخ» الذي يدبرونه له: «يريدون ان يزوجوني» ولعلعت ضحكته فكانت اغرب ضحكة سمعتها. بدا ساهيا وإن لم يكن كذلك في الحقيقة، فلم يفته تفصيلا في المكان واشخاصه لم يتناوله او يسخر منه. كانت حمدة خميس تغذي ضحكه المتواصل بحكاياتها عن لغة الهنود العاملين في البحرين، في محاولتهم الى «الانسجام» مع أهل البلد، بعربية معاقة، اغرقت سركون في «مود» منشرح، فهمس لي أخيراً انه قرأ بعض قصائدي.
كلما همت حمدة الى الصمت، كان سركون الضخم يتوسلها كطفل ان تعيد على مسامعه «خبرية» السائق الهندي ووجهة نظره في الحياة والكون.. والعرب.
الشاعر الذي بدا فائضا في أمسياتنا، وفي شعرنا، وكلامنا وأكلنا وشربنا، كان انتقائيا الى درجة قاسية، وحنونا الى حدود قصوى. كنت اعلم في سري ان حكاية اصرار اخيه على تزويجه، حكاية ملفقة بالكامل، سوى انني تواطأت معه في لعبته وعرضت ان نهرب الى مكان ما، فأطربته الفكرة.
لن نأس على سركون في موته فلا يحق للسرطان ان يؤلمه بعد. رحل الرجل، وكان قد عاش على قياس رغبته بالعيش. عاش كثيراً جداً في وقت قليل، وكتب الذي كتبه، وقد خلفه لنا أخيراً لنهتدي الى الشعر في الحياة، وليس في الكلمات. عشقته نساء كثيرات، وكان يأنف الكثرة في عشقهن، يلون الوقت بالأكل والخمر والترحال.
كان لي شرف منادمة شاعر ذات يوم. وأحسبه لم يرث نفسه في وحدته حيال الموت، فقد خبر ما هو اقسى، وما هو أمر، سوى انه رحل أخيراً بذخيرة طيّبة من الاماكن، والكلمات، والتفاصيل والعلاقات الخفيفة التي لا تثقل على القلب، ولا تجعله يدمع حين يؤذن الرحيل.
عناية جابر
لا حدود بين الكلمة والحياة
كان من قلة قليلة أشعر بانتمائي إليه، إلى عالمه الشعري الذي سحرني ولا يزال. أشعر فعلا أني فقدت أحد آبائي الذين أدخلوني إلى القصيدة الجديدة وإلى الكتابة الشعرية في ما بعد. صحيح أني لا أنتمي إلى قصيدته كتابة، أي بمعنى استعادتها والنسج عليها، لكن هذه المخيلة النابضة التي كان يتحلى بها، كما لغته الجديدة البعيدة عن تهويمات شعر تلك الفترة، فتحتا لي آفاقا عديدة في الكتابة الشعرية. أعتقد أني جئت من هذا الاختلاف، من هذه المجموعة التي خرجت من كركوك وضمت كثيرين غيره. بمعنى آخر، تعنيني أكثر تجربة مجلة «الشعر» العراقية أكثر من نظيرتها اللبنانية، لأنها جعلت من الشعر قضية إنسانية بامتياز، بينما توقف الفكرة اللبنانية عند قضيّة اللغة. قول لفاضل العزاوي في كتابه «الروح الحية» (كتابه حول تجربة الستينيين العراقيين) ولا أستعيده هنا إلا للدلالة على هذه الحركة التي فتحت وعيا حقيقيا لم ينتبه له الكثيرون، بالأحرى لم يرغبوا في الانتباه إليه، إذ كانوا مهتمين بقضايا أخرى، غير شعرية بالدرجة الأولى.
سركون كان واحدا «من أولئك» الذين تقرأهم، ويبقون حاضرين معك طيلة حياتك. قرأته للمرّة الأولى في بداية الثمانينيات، يومها كنا نبحث عن مصادر شعرية جديدة، غير تلك التي تعرفنا عليها. حشريتنا هذه قادتنا إلى اسمه، وكانت الصعوبة أن نبحث في المجلات القديمة عن نصوصه الكثيرة، التي لم يجمعها إلا في الثمانينات، في ديوان أول، بعنوان «الوصول إلى مدينة أين». كتاب حقيقي لجيلي، في تلك الفترة (مع أشعار وديع سعادة وعباس بيضون)، اللذين قادانا إلى عوالم أخرى، بدت بهية بكل اختلافاتها التي صدمت وعينا بنص لم نكن على دراية به. صحيح أن القراءات استمرت وتعرفنا على أصوات أخرى، وأصبحت مصادر الشعر لدينا، تغرف من وجهات أخرى، إلا أنها كتب حفرت عميقا، وأظن أنها لا تزال.
قلة هم الذين جمعوا بين الحياة والشعر، كان يعيش شعره إلى أقصاه، ويكتب حياته إلى أقصاها أيضا. ألغى الحدود الفاصلة بين الكلمة والحياة. جعل من الأمرين منبعا واحدا، ليرسم عالمه الخاص، الاستثنائي.
لا أريد أن أرثي شاعري. صحيح أن فقدان شاعر بحجم سركون بولص، لا بد أن يترك فجوة ما، في الشعر، في الحياة، في اللغة عينها. وصحيح أن (الإيميل( الذي يصلني صباحا من خالد المعالي يدخلني في كآبة، لا أعرف كيف الخروج منها، إلا بليتر من الفودكا، إلا أنه يكفي أن نعود لنقرأ شعره، لنحس كم أن هذه الحياة تفقد الكثير من معناها. هذا ما سأفعله: سأقرأ شعره اليوم، وأمامي هذه القارورة. فقط لنقول كم كنا نحبك. لنقول كم أنت سمجة أيتها الحياة.
اسكندر حبش
يكتب ما وراء النسيان
كان يقول قبل يومين فقط انه سيذهب الآن، الى أين تذهب يا سركون. كنت أسأله فيجيب: الى بيتي. أي بيت تقصد؟. كان يردد الى بيتي. سركون المعلق على كل الطرقات، الراحل بين المدن والقصائد لا بيت له في هذا العالم. يكتب أوديسا الرحيل دائما، يمسك بالفراغ وهو يجتاز مسافات العبور الى العراق «أصل الى وطني بعد أن عبرت / نهرا يهبـط فيه المنجــمون بآلات فلكية صدئة / مفتشين عن النجوم/ أو لا أصل الى وطني/ بعد ان عبرت نهرا لا يهبط فيه أحد».
سركون بولص لم يضع الفاصلة الأخيرة في كتاب إبداعه، بعد أن تركه مفتوحا للآخرين. ومثل متشرد، عاش الشعر والحياة في تزاحم لا يدري أيهما الخاسر في جولة السباق تلك. كان الشعر انخطافة يعيشها وهو بين جلاسه، ترحل عيناه الى أماكن غريبة، ويتمتم بكلام لا يسمعه غيره. والقصيدة تلك التي تكتب نفسها، تفلت منه، ولا ينتظر هو عودتها، فقد كان شعور الغربة يملأ روحه باكتفاء من نوع خاص، زهد بالحياة وقوانينها. يأكل كل شيء ويعيش الصدفة، لحظة صمت او صداقة أو ضحكة او خصومة مع الماضي والحاضر. سركون المثقف النادر الذي يمتلأ رأسه بالكتب، يعود الى الحياة عندما يكتب الشعر، فما خلّفه من طفولة في تلك القرى المسيحية ينبثق برأسه، مثل دليل على ما قطع من سبل الوصول الى هذا المكان. فهو يضع نفسه في المنطقة العازلة للشعر حيث كل شيء يبدو وكأنه محض اكتشاف أولي: المشاعر والذكريات وملامسة الحياة «الموقد البارد في الزاوية/ يطق مرة ليذكرني بأن أسفاري/ ضد الزمن، وليس لي أن أحمل الأشياء/ على ظهري حتى الابدية، أو أرفع هذا الميت / من إبطيه عن درج بيتي». تلك المنخوليا التي تعصف بروح سركون، كانت تأتيه بعالم قيامي يشاهد فيه الضفاف وهي تفور بالموج، والأرخبيلات وهي تجتاح المدن، والشباك وهي تجرف العبيد من الأنهار. الماضي يتحرك داخله لا من ارشيفات قديمة، بل مما اختزنه الفكر من رحلة مضنية، لذا لن نجد السرد في قصيدة سركون مجرد تخيل او استرجاع، بل هو اكتشاف الكون والخليقة، انفعال التعرف على النطفة الأولى للموت والحياة. هو يكتب ما وراء النسيان، كي يتذكر تلك الاسترجاعات الغامضة لروح الاسطورة. التوتر الذي يسوق قصيدته الى لغة ثرة وصور محبوكة ودقيقة، يمضي به الى عالم يبعده عن كل كلام فائض ومكرر.
ذعر سركون من الحياة، جعله يبتعد عنها، ويخطئ في تصويب أهدافه اليها، ولكن من قال إن الأسبقية للعارفين بهذه الحياة ابنة الزانية كما يسميها.
فاطمة المحسن
عمـارات اسـتدراج الذائقـة
رحل سركون بولص شاعراً كبيراً صاحب تجربة كبرى، بالغة الحضور، واسعة التأثير. ورحل شاعراً مقلاً بالقياس إلى عدد المجموعات التي أصدرها، لا سيّما أنّ مجموعته الأولى لم تُنشر إلا سنة ,1985 حين تجاوز سنّ الأربعين. هنا مفارقة أولى ذات مغزى في تجربة بولص: أنّ الحجم الكمّي لنتاجه الشعري لم يتناسب البتة مع حجم التأثير النوعي الهائل الذي مارسه، منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم في الواقع، على جيلين متعاقبين من الشعراء العرب، وشعراء قصيدة النثر على نحو أخص.
وليس بغير دلالة قصدية أنّه كان، في مجموعته الخامسة «إذا كنت نائماً في سفينة نوح»، ,1998 قد أعاد إدراج عدد من قصائده القديمة التي تعود إلى الفترة الممتدة بين 1969 و,1982 ليس لأنها ترتدي أهمية بالغة في مسار تجربة بولص الشخصية فحسب، بل لأنها شكّلت علامات فارقة في أقدار الشعراء العراقيين الستينيين (فاضل العزاوي، عبد الرحمن طهمازي، صلاح فائق بصفة خاصة)، وفي التاريخ المتقطّع القلق لقصيدة النثر العربية إجمالاً. وفي تعقيب يوضح سبب إعادة نشر هذه القصائد كتب بولص يقول إنها كانت «نتاج مرحلة واحدة تقريباً بدت لي فيها جميع منافذ الكتابة العربية، لأوّل وهلة، مسدودة في وجه التجربة الجديدة التي كانت تكتسحني آنذاك والتي توقفت عن الكتابة، زمناً، لأنغمر فيها بكامل جسدي ومخيلتي وأمضي بها إلى النهاية».
والحال أنّ امتزاج هاجس التعبير الجديد بقلق اجتراح الشكل المغاير كان في رأس هموم بولص منذ البدء، وهكذا ظلّ حتى آخر قصائده التي نشرها قبل أسابيع قليلة. ولهذا فإنّ الحديث عن شعر بولص سانحة دائمة لممارسة بعض «الانضباط» التحليلي في تمييز مصطلح «الشعر الحرّ»، أو «قصيدة التفعيلة» كما نقول اليوم، عن مصطلح «قصيدة النثر». ولقد بات معروفاً الآن أنّ مناخات التجديد الخمسينية، التي كانت غائمة مضطربة بقدر تلهفّها على إحراز قفزات دراماتيكية، سمحت لنازك الملائكة باستسهال إطلاق تسمية «الشعر الحرّ» على القصيدة التي تحرّرت من عمود الخليل ولكنها ظلّت مُلزَمة وملتزمة بـ«عمود» تفعيلي ليس أقلّ نسقية، وبنظام في التقفية ليس أقلّ جموداً. كذلك سمحت لأدونيس، وسواه، باستسهال مضادّ في إطلاق تسمية «قصيدة النثر» على كتابة شعرية تحرّرت من الوزن والقافية، ولكنها ظلّت ملزمة وملتزمة بـ«عمود» مستتر إذا جاز القول، كان سطراً طباعياً صرفاً بالطبع، ولكنه في الواقع كرّس التقطيع إلى أسطر شعرية مجردة وتجريدية، وعشوائية عموماً، واستولد الكثير من الالتباس بين السطر الجديد والعمود القديم.
امتياز نموذج سركون بولص كان الاشتغال الدؤوب، والشاقّ تماماً، على استقصاء تلك الهندسة الغائبة، أو المتعثرة في أفضل المقترحات، والإلحاح على انبثاقها من وسيط النثر في ذاته، واعتمادها على ديناميات النثر وليس شَعْرَنته فقط، على نحو يمسخ طاقات النثر بدل أن يطلقها. وبهذا المعنى فإنّ من الإنصاف البسيط ضمّ بولص، وعدد من الشعراء مجايليه، في العراق ولبنان خصوصاً، إلى صفّ ريادة قصيدة النثر العربية في جانب جوهري وتكويني من مشاقّ كتابتها: البحث عن الحلول الفنية الكفيلة باستيلاد عمارات إيقاعية رفيعة، متغايرة على نحو مَرِن، جذابة ولافتة، قادرة في الآن ذاته على منافسة التفعيلة في استدراج ذائقة حرونة متجبرة، ظلّت طيلة قرون أسيرة نظام السماع والأذن والتلاوة الجهرية.
هنالك جانب آخر حاسم في شعر بولص، أتيح لي أن أتوقف عنده في مناسبات سابقة، هو أننا بحاجة إلى نماذجه في المستوى التربوي والتعليمي، إذا كنّا سننجح ذات يوم في إدخال جماليات قصيدة النثر إلى المناهج المدرسية في التعليم الثانوي على سبيل المثال. ففي قصيدة بديعة مثل «إلى امرئ القيس في طريقه إلى الجحيم»، من مجموعة بولص الرابعة «حامل الفانوس في ليل الذئاب»، ,1996 يقول بولص: «ضيّعني أبي صغيراً» أجل ضيّعني ولن أستريح/ «اليوم خمرٌ، وغداً أمرٌ» تقول الريح/ ولي خمر وجمر ومعلّقةٌ/ قد أهزِمُ بها جنيّاً يزورني في مثل هذه الساعة/ في مثل هذه الساعة دوماً كأننا على موعدٍ/ لا يقبل التأخير محمّلاً بكلّ ضغائني/ ليعلّمني أسرار السواد في سراديب سويدائي/ وهذا الغسق اللعين، المتكاثف ظلاً فظلاً ليعلم أنني/ أحلم في آخر قطرة ترشح من سَدولهِ/ بأنواع الهموم، بأنواع الهموم!». وليس عسيراً أن ندرك البعد التربوي في كيمياء هذه القصيدة: أنها تصنع شبكة بارعة، وخافية، لاستدراج قارئ الشعر المتوسط على دفعات: إثارة فضوله، إلزامه بالركون إلى منطقة وسيطة بين القراءة الصامتة والقراءة الجهرية، استثارة ذاكرته الإيقاعية واستنفار أوالياتها الراسخة المطمئنة، استفزاز أعرافها، وصولاً إلى اقتياد القارئ نحو «مصالحة» من نوع ما بين ذاكرته الإيقاعية وهذا الاقتراح الإيقاعي الطارئ.
وغنيّ عن القول إن تجربة الراحل الكبير اشتملت على العديد من الاختراقات التعبيرية والفنّية والجمالية، فضلاً عن تلك التي تخصّ موضوعات قصائده، وليس الحديث هنا عن جانبين فقط في تلك التجربة إلا من طراز الاختزال الذي يقتضيه المقام.
صبحي حديدي
مَـن يذكـر سركـون بولـص؟
قبل أن ألتقيه كنتُ أحسبُ أن سركون بولص لا وجود له إلاّ في ظنّي.
ثمّ التقيته في مناسبة وحيدة، قبل بضع سنوات لا أذكر عددها، في بهو فندق «القدس» في عمّان، إذ كنّا من بين المدعوين للمشاركة في فعاليات «مهرجان جرش».
لعشرة أيام كنّا نلتقي في بهو الفندق، مدعوين، شعراءَ من البلدان العربيّة كافّة، لساعات طويلة.
ولم يكن الشعر حاضراً في مجالسنا.
لم نكن نحن كشعراء حاضرين في مجالسنا.
بعد ذلك عاد كلّ منّا إلى بلده أو إلى منفاه. ما عدا سركون بولص؛ كانت رحلة عودته (إلى أين ؟) تتخلّلها محطّات في عواصم عربيّة وأوروبيّة، ولا يدري أين ستكون محطّته الأخيرة.
رحلة عودة على سبيل المجاز. فلكي تعود لا بدّ لك أولاً أن ترحلَ عن مكان بعينه لكي تعود إليه.
من أين بدأت رحلة سركون بولص؟ أين أقام قبل ذلك؟ وإلى أين يعود؟
أعرف مَسْكناً واحداً لسركون بولص هو اللغة. ولعلّ هذا ما جعله في ظنّي، قبل أن ألتقيه وبعد أن التقيته، شخصاً من المعاني. لن تعرفه جيّداً مهما حاولت ولكن يسعك على الدوام أن تحاول تفسيره.
كما يفسّر كلّ شيء لكي تَنْزَع عنه لبساً فيرتدي ألف آخر.
لو كان سركون بولص رجلاً ينتمي إلى مكانٍ نشير إليه، بسبّابتنا، على الخارطةِ التي نعلم أنّها جغرافيا أفكارنا، لما تعذّر علينا أن نذكره جيّداً. أقصد: ملامح وجهه؛ علاماته الفارقة؛ قوامه؛ مشيته؛ ضحكته؛ أو الطريقة التي يمسك بها كأسه أو سيكارته.
لو يخرج قليلاً من ظنوننا لأدركنا له هيئةً وحجماً ووزناً.
غير أننا نعجز اليوم عن استذكارِه إلاّ بما ساقه على الورقِ من تصاريف اللغة. وهي البلد الوحيد الذي جاهر سركون بولص بانتمائه إليه.
هناك يكون في بيته.
لا يخترع أو يبتكر أو يجهد في اجتراح المعجزات، بل يحيا، كما يحيا المرء في ملاذه الآمن، ويفكّر ويتكلّم.
لطالما أقمتُ على ظنّي بأن سركون بولص كائن يفكّر ويتكلّم في ظنّي. إذ لم أجد له أثراً، حتّى بعد أن التقيته، إلاّ في الكتب التي نعاود قراءتها، مراراً وتكراراً.
ولطالما أقمتُ على الظنّ أنني إن محوتُ ما أخلّفه من أثرٍ في عبوري بين عابرين فقد ألتقيهِ ذات يوم في ترحاله المتمادي.
من يذكر سركون بولص؟
ومن يدري أين سيُجعَل مثواه الأخير؟
ولكني أحسب أن ما يليق بمثلِه هو أن يقام له ضريح على هامش كتاب السير المستحيلة؛
أو في شروح موسوعة الموتى والعابرين؛
أو في فهارس المدنِ ومعاجمها.
بسام حجار
بحثـاً عـن الصابئـة
بخليط من الحنق والكحول، امتطينا «الرانج روفر»، فادي توفيق وفادي طفيلي وأنا ليقودنا فادي أبو خليل في جولة بعد منتصف الليل في شوارع الأشرفية بحثا عن الصابئة.
نقف أمام كل دكان مفتوح ونترجل داخلين اليه لنسأل: «هل من صابئة هنا؟».
قضينا وقتا طويلا تلك الليلة المكهربة نفتش عن آخر صابئة على كوكب الأرض.. هنا في أحياء بيروت الشرقية.
أتذكر هذه الحادثة وأنا أفكر برحيل سركون بولص، صاحب أجمل عنوان لكتاب شعري باللغة العربية «الوصول الى مدينة أين». أظن ان بحثنا عن الصابئة تلك الليلة كان تمرينا على الوصول إلى مدينة سركون بولص.
يخطر ببالي أيضا «الهروب من الكتراز» فيلم كلينت ايستوود، طالما ان سركون كان هناك مع الفتاة الهيبية، الهندية الحمراء، جالسين على شاطئ سان فرانسيسكو يرمقان السجن ـ الجزيرة، فيما هو ـ حسب ما أتخيل ـ يفكر في الأكاديين والسومريين والآشوريين والكلدان والصابئة، وهي تفكر في آخر ماهاغوني من قبيلتها... وكلينت ايستوود في الأثناء يحفر بالملعقة جدار زنزانته.
في المرة القادمة، لن يكون سركون موجودا معنا ليحمل الفانوس بحثا عن اليزيديين في شوارع بيروت، ولا فادي أبو خليل الذي يبحث عنه يحيى جابر ما بين مطعم بربر ومقهى الويمبي.
لم ألتقِ في حياتي هذا الشاعر، أنا المغرم به.
أحتفظ في رأسي بصورته تلك المنشورة على الغلاف الخلفي لمجموعته «الوصول الى مدينة أين» صورة شاب بأناقة بوهيمية وشعر طويل وفق موضة السبعينيات. لقد أغرمت به كامرأة في صورته تلك. كنت فتيا، ووددت ان أكون بمثل مظهره عندما أصبح رجلا ناضجا. اذ خيّل إلي ان رجلا بهيا وجميلا كهذا وفي الوقت نفسه هو شاعر لا يمكن ان تقاومه النساء.
بدا لي ان صورته مخالفة تماما لـ «بوزات» الشعراء الذين يضعون يدهم على وجههم كعلامة على عمق التفكير والتأمل. تلك «البوزات» المضحكة حلت محلها هذه اللقطة لسركون بولص: شاب لعوب مزهو بجسمه وجاذبيته، ممتلئ بعلامات الحياة الخارجية، لا صريع الصومعات والعزلات.
أغرمت باسمه حرفا حرفا، سركون بولص. عندما ألفظه أسمع جرس الحنين الى هذا المزيج الوثني ـ المسيحي، وأشعر بانحيازي المرضي لما هو أقلوي وغرائبي ومنفي من التاريخ.
كنت باستمرار أتخيله بطلا سينمائيا أكثر مما هو شاعر عربي مضجر ومنتفخ بلغة الضاد.
لسبب أناني أنا مسرور اذ لم ألتقه في شيخوخته ولا رأيت صورا جديدة له. فسركون بولص الذي يخصني ما زال حيا.
يوسف بزي
صلـة مـن لا يصـل!
وصلت إلى بيروت هارباً أو عابراً نهاية عام 1991 بعد رحلة لا تخلو من الجهد! وفي جلسة بمقهى المودكا اجتمعت بالشاعر عباس بيضون والفنان الراحل رفيق شرف، الذي كان يعدل من قبعته ويتذكر كمن يبحث عن وجه قبطان ضائع ليسألني هل تعرف سركون بولص؟ هل لك صلة به!، قلت له ربما كانت رحلتي تشبه تلك الرحلة، رحلة لا تصل مطلقاً لكنها لن تعدم المحاولة. وصلتي به هي فكرة الوصول وليس الوصول ذاته!
والواقع أن من يقرأ تجربة سركون بولص بعناية سيجد أن هذه الفكرة تحكم مجمل تجربته بخيط لا يبدو جلياً تماماً لكنه لامع ودقيق كالحبل السري إذا ما سلمنا بأمومة الشاعر لقصيدته.
فالوصول لدى سركون، ينفصل عن جادة المعنى القار في الأذهان، وينحرف عن بوصلة الميراث، سواء بمعناه المعجمي، أو باصطلاحه المتشكل بتطور الدلالة، فهو لا يعني بلوغ الشيء أو الحد، وحتى عندما يقول في مستهل قصيدته ( آلام بودلير وصلت): وصلتُ إلى الحد ... فإنه سرعان ما يبعثر فكرة الوصول، بتناسل صوري مقصود، يعبر عن تكرار المحاولة فحسب.
ليس الوصول أيضاً إلا مجرد مقترح لصلة غائبة بين عناصر الزمن المتفكك، في صور من الماضي وشظايا غير فارة من الحاضر.
من هنا فإن الصلة التي تريدها مجمل تجربة سركون مع الراهن، ليست سوى خيبة جميلة تحدث هذا التصادم المرسوم بعناية فائقة بين شيئيات نوعية لا ضدية.
إنها الصلة التي تعوض عن الوصول الممتنع، المتعة التي يتحدث عنها جورج باتاي بوصفها (الهروب الذي لا حد له، كما لو أن حياتنا أنهار تجري ببطء من خلال حبر السماء!)
من هذا المعنى، أو ربما بشيء منه، سنجد تفسيراً لطبيعة الصلة التي تشد معظم شعراء جيلنا في العراق، بشكل خاص، إلى قصيدة سركون بولص، وشعر جماعة كركوك بالعموم، مع إن هذه الصلة، قد لا تمثل أرضاً صلبة صالحة لوقوف الكثيرين عليها.
فعندما بدأ جيلنا يتشكل أوائل الثمانينات، كانت سلالة الشعر العراقي قد تفرقت كأيدي سبأ أو كرحلة العبراني إلى الجهة الأخرى، ثمة أصداء لشعراء بقيت عند الضفة الشرقية، وثمة هوامش بعيدة كادت تنطمر تحت ركام زائف.
لم ننظر إلى جماعة كركوك إلا بوصفها ذلك الهامش الذي اختار عزلته أو قل انعزاله، كي يحدث أثراً آخر في الشعر العراقي. أثر الهامش الذي يقتفيه هامش آخر إلى حين ثم سرعان ما ينفصل لتعدد الهوامش، ويغتني الشعر من مكان آخر، بعيداً عن المتن المتكدس بلا تعيين!
ومن بين شعر جماعة كركوك، أهم تيار في نهر الشعر الستيني في العراق، تنهض قصيدة سركون بخصوبة، وتنفرد كشجرة وحيدة في غابة بعيدة!
وما بين رفض فاضل العزاوي الذي يقترب من النهليستية، وصور صلاح فائقة السابحة والغارقة أحياناً في بحر السوريالية، تنهض قصيدة سركون مسكونة بالأرواح والأشياء، ضاجة بالأسئلة والأخيلة، وهي مسترخية في قارتها، قصيدة تنبي الشعر لتتبناه، ليصح عليها قول أبي تماما واصفاً قصيدته بقوله:
وحشية أنسية كثرت بها
حركات أهل الأرض وهي سكون!
[[[
ذهب الكركوكيون جميعهم، في رحلة متعددة الجهات، وتركوا لنا جان دمو لندلـله، ذكرى وحيدة من رحلة لا تصل!
فيما ظل من سركون، شاعر قصائد، وصلة لعدم الوصول ذاك، فليس ثمة ديوان قد صدر له حتى ذلك الوقت فمجموعته الأولى (الوصول إلى مدينة أين) صدرت في منتصف الثمانينات، ولم تصل إلى مدينتنا السؤال، إلا بعد وصوله هو إلى بغداد مدعواً لأحد المرابد الشعرية ليكثف السؤال مرة أخرى، ويمضي غامضاً كذلك.
شاعر قصائد يشبهنا تقريباً نحن الذين ننشر قصائدنا هنا وهناك، ولا نصدرها في كتاب، فمطابع البلاد مخصصة للمعركة، ولشعراء أدب قادسية صدام.
لم يكن بعثياً ولا شيوعياً، لم نعرفه إلا هكذا، شاعراً مجرداً من النعوت الزائدة والزائفة أيضاً، صلة أخرى للمحارب الآشوري المتقاعد، بيننا نحن المحاربين الشباب في الكولوسيوم الروماني الجديد في وادي الرافدين!
لكن من بين مجمل جيل جماعة كركوك وجيل الستينات عموماً أزعم أن معظم شعراء جيلنا مدينون في تصعيد تجاربهم لتحريضات هذا الثلاثي: العزاوي وصلاح، وسركون، من بين جماعة كركوك ومجمل الجيل الستيني في العراق.
ووسط دخان الحرب العراقية الإيرانية كنا مشغولين، بمواجهة الموت بإعادة تشكيل الخارطة الشعرية للستينات في وقت لم تكن تخرج فيه عن أراجيز المعركة التي كانت تنشر بشكل يومي وبتصاعد بياني مع اشتداد المعارك، سوى قصائد لا تكاد تقول شيئاً لحميد سعيد وعبد الأمير معلة وبدرجة نوعية مختلفة قليلاً: سامي مهدي.
وبينما يدأب معظم الشعراء على شحن مفرداتهم بدلالات حد إثقالها بعناصر متداخلة ومرتبكة غالباً فإن مفردة سركون مفرغة من عبء الدلالات التقليدية وصافية حد العري من أخلاقيات الإرث البلاغي، إنها توضع لتولد في الغالب في سياق الجملة وليس لتضيف أو تصف أو تفسر.
ولأن ذاكرته حياتية أكثر من كونها ذاكرة لغوية، فإن بلاغة أخرى ستنهض في قصيدة سركون، بلاغة تمتح من بئر الشخصاني، وليس من ترجيعات اللغة.
البلاغة في قصيدة الآشوري الضائع، ليست متوارثة، بل إنها مرثية للبلاغة بمعناها الاستعاري والاستعادي أيضاً، فهي مجاورة شيئية أخاذة، تخلق قاموساً آخر، ليس بحشد المفردات ومقدار الإزاحة التي تخلقها وتخلفها في علاقتها البينية، بل في المسافة الشيئية التي تكشف عن سرية، أبعد من وهج اللغة الطافح دون انطواء.
فمع كل المغترب الطويل لسركون بولص إلا إنك تستطيع أن تهجس البيئة الأولى تنهض في قصائده، حكايات قديمة، وذاكرة مدببة التفاصيل، وغائرة في جهات لم يصلها أحد، خاصة في ديوان (الأول والتالي) النموذج الأفصح لتمثل هذه الفكرة.
الأمكنة التي يتحرك من خلالها فانوسه السحري، ليست أمكنة مظلمة بالمعنى الفيزيائي للظلام، لكنها متماهية بحدث يبتعد، وهي منطوية عليه كما ينطوي الحدث نفسه على علته، المقهى أو الحانة في مكان وراء البحر هما جانب من الصلة السرية مع مصافي النفط في كركوك، ونوم الأبقار في ظلها، أتذكر قصيدة له ليست بين يدي الآن مع الأسف، يستعيد فيها صورة الرجل الذي ينظف بئر المرأة، ويدلي بحبله ودلوه لينظف تلك البئر في المنزل، معادل إيروتيكي لا يخلو من وطأة هنري ميلر في نسج الجمال من نفايات!
[[[
ليست الأسطورة لديه امتداداً للنموذج البدئي بل هي ابتعاد تام عنه، لذلك فإن ثمة بنية مضمرة تتسرب في الحكايات المنقولة من التراث الشفاهي والبيئي الغامض، ممهورة بكل ما هو شخصي في التجربة والمعرفة.
بهذا المعنى لن تكون الأسطورة ديباجة أخرى، وتزييناً خارجياً لوجه القصيدة، إنها عصبها الداخلي، ليس شعر سركون هنا الندرة الوحيدة، في هذا المجال، لكنه الأكثر جوانية وسرانية في استبطان الأسطورة، ستبدو قصيدته من الخارج قصيدة يومية شخصية تلتصق بالحياة بالمتحقق منها، لكنها في الباطن موارة ببنية هائلة من خزائن المثيولوجيا التي لا تلمع بسهولة.
وربما سنلمس عناية بالموروث الشعبي، والتجربة الشخصية، على حساب التراث الجمعي، ولعل هذه واحدة من صفات مجمل شعراء جماعة كركوك، صفة قد يجد فيها البعض مثالب، وقد يتوسم فيها آخرون مناقب، ومآرب أخرى، وسركون بهذا المعنى شاعر بيئة أكثر من كونه شاعراً معنياً بتاريخ الشعر العربي كثيراً، ستصدف ذلك في تحرك جملته التي لن تجد حيزاً كبيراً لها في الذاكرة المتوارثة، لكنها ستزيح حيزاً في الذاكرة ذاتها لتشغل زاوية من الجمال، لن تطرده الذاكرة تماماً مثلما لن تستطيع قبوله بسرعة.
[[[
البناء النسيجي للصورة، يجعل من قصيدته جسداً فوق ما هي عليه من شعر! ليس ثمة كتلة نافرة، أو نبرة حادة إلا بما يجعل قصيدته استواء محكوماً بالبناء الخيطي الذي عنيته، وإذا كانت العبارة الشهيرة لماكليش صاحب الشعر والتجربة التي تقول: لا ينبغي للقصيدة أن تعني بل أن تكون، هي بمثابة درس في بناء القصيدة وهندستها، فإن قصيدة سركون تعطي درساً آخر في سؤال الكيف والماهية، إنها تريد للشعر أن يعني وللقصيدة أن تكون في الوقت عينه.
أيها الماضي أيها الماضي
ماذا صنعت بنفسك أيها الماضي.
[[[
لم ينل شعر سركون بولس كشأن العديد من الشعراء العراقيين عناية نقدية جادة، لكنه بالتأكيد لم يعدم تلك العناية من شياطين الشعراء! سركون بهذا المعنى (شاعر الشعراء) والإضافة هنا ليست تفخيمية متنطعة، بل قصدت أن الشعراء بشكل خاص هم الذين يفهمون أهمية قصيدة سركون.
الآشوري الضائع في البحث عن فكرة الوصول. يبدد الفكرة كمن يريد أن يصل إلى الحياة أو يستبدل إحداهما بالأخرى.
محمد مظلوم
إنها مدينته الغامضة
سركون بولص المتطوح في الآفاق كان يحمل في داخله صبايا عراق ما في أي مكان حل فيه، في الولايات المتحدة الأميركية حيث يموت الشجر ويزدهر الحجر.
سركون بولص من الأساس حمل أشلاءه، مِزق يديه وعينيه ومشى، ولكن ليصــل الى مدينة ليس ثمة ما هو أكثر غموضا منها، لا هي بغداد ولا سامراء ولا نيــويورك ولا واشنطن، ولا حتى ما أوحى لنا به من اقامة الى جانـب الأكروبــول. انها مدينة سركون الغامضة الصعبة التي سماها «مدينة أين»، لأنها تقيم في اللامكان، تقيم في لغة سركون بولص التي هي مزيج من أشلاء وحرية، دم وبلاد.
عاد بولص الى أصله.
محمد علي شمس الدين
نقــاء الينبــوع
فاجأني نبأ رحيل سركون بولص، الشاعر الفريد والصديق الاستثنائيّ، وأنا أضع قراءة طويلة لمجموعته الشعريّة الجديدة «عظْمة أخرى لكلب القبيلة»، التي تظهر بعد أيّام إلى النور، وقد أتاح لي الفقيد والدّار الناشرة لأشعاره (منشورات الجمل) أن أنال منها قبل سواي نسخة ألكترونيّة. وإذ أسترجع الآن صوَر هذه المجموعة وعوالمها التي لم تغادرني بعدُ رجّاتها العميقة، وأتذكّر المسار الوجوديّ لسركون، وأستعيد حواري الهاتفيّ معه قبل أن يعود إلى منزله في سان ـ فرانسيسكو منذ أيّام، حوار متلعثم وناطق مع ذلك بحقائق خطيرة في الشعر والحياة تلزم لتدوينها مقالة كاملة، إذ أقوم بهذا فأنا ألتفت إلى أنّ الشعر العربيّ قد عرف مع سركون حالة لم يعرفها هذا الشعر إلاّ في ما ندر، تلك هي حالة شاعر نذر حياته وعصب فكره وقواه الإنسانيّة بكاملها للشعر وحده.
لم يشأ سركون أن ينخرط في حياة قارّة أو ثابتة، معروفة المهامّ ومحدّدة المعالم، وقبلَ بالعوز وتحمّلَ نكران المؤسّسات الثقافيّة العربيّة وسواها، غيرةً منه على هذه الحريّة المديدة التي طالما بدتْ وهي تشكّل له الرديف الأساسيّ للشعر وحليفه الوحيد. حريّة مديدة، يرافقها ويدعمها عمل مديد على الشعر واشتغال على اللّغة دائم. لم أعرف في الحقيقة شاعراً عربيّاً أكثر احتفاءً من سركون بالعمل المستأنَف على القصيدة، ولا أكثر منه انهماكاً بتنقيح كتاباته، لا يهب للنشر صفحة واحدة ما لم يطمئنّ قلبه أو وعيه اللغويّ وحاسّته الإيقاعيّة المرهفة كأقصى ما تكون عليه الرّهافة، والمدرَّبة كأبعد ما يكون عليه التدريب، أقول ما لم يطمئنّوا إلى استقامتها وإلى اتّباعها الحركة المجنّحة تارةً، والمبطئة عن قصدٍ طوراً، التي يريد هو لها أن تتبعها.
عرف سركون الشعر العالميّ في أغلب نماذجه وأرقاها، عاقرها عبر أفضل ترجماتها إلى الإنكليزية، وطويلاً تردّد على الشعر العربيّ، القديم منه بخاصّة. وكان أبو تمّام هو مَن نال حصّة الأسد من إيثار سركون وإعجابه. ولم يكن أبو تمّام الغامض ولا المتحذلق بالكلام هو الذي استأثر بإعجاب سركون حتّى لقد عدّه معلّماً له، إلى جانب ريلكه وآخرين قلائل، بل صاحب الصّنعة فيه، بمعنى ديناميّ وأصيل للكلمة، رجل الحرفة والعمل الدؤوب، العامل المنحني أبداً على سندان الكلام والممسك بمطرقته، هذا الذي يشتغل على القصيدة حتّى في سيره ونومه وأثناء أحلامه.
ذكرتُ الإنسان السّائر، أو الماشي، ولقد كان سركون بالفعل، حتّى في سنوات اعتلاله، مشّاءً كبيراً، يعشق انتهاج الطرق الكبرى والسّير على غير هدى ودونما هدف. وطالما قال لي إنّ الكثير من قصائده (وكان ممّن يكتبون بين آخِر اللّيل وأوّل الصبح) كانت «تتعطّل» قبل نهاية الشّوط المفضي إلى اكتمالها، تحرن كالبعير الغاضب وترفض الانصياع لحركة خياله. فيرتدي ملابسه أيّاً كانت السّاعة ويشرع بجولة هادئة، شبه مستسلمة لقوّة تتخطّاه، قوّة هجرتْه منذ لحظات لكنّه موقن أنّها ستعود إليه. تعود إليه لا بفعل سلطان يترك هو لسواه أن يدّعوا امتلاكه على الكلمات، بل تقديراً لوفائه العنيد وحده. وبالفعل، فسرعان ما كانت جولته اليائسة والفرحة في آنٍ تعود له بلقيته الثمينة المنتظرة، فيرجع إلى داره ويدوّن بقيّة القصيدة التي انخطّتْ من قبلُ في خيال الرّجل الماشي الذي كانه هو. هكذا يمكن القول إنّ الكتابة الشعريّة كانت تتبع لديه طقوسيّة سحريّة نوعاً، قائمة على الهيام والانتظار العنيد والشحذ المتمرّس للرؤى والأفكار.
موهبة السّير هذه، فاعليّة السّير في العالَم وعبر طرق الذاكرة وفي قارّات المخيّلة الفسيحة، هذا التحرّر المستميت والانفتاح المتمرّد، يرافقه عمل ودأب وتلمّس وحنكة، هذا كلّه هو ما يشكّل الهبة الأساسيّة التي تقدّم بها سركون للشعر. في هذه الهبة وجدتْ شبيبة شاعرة وتوّاقة إلى الجديد والصّادق والحقيقيّ سبباً كافياً للمغامرة وسبيلاً ولا أنصع للاقتران ببساطة مشعّة كانت هي بحاجة إليها وكان سركون واحداً من القلائل الذين وجدوا إليها درباً. بساطة هي نضال يُخاض في كلّ جملة من أجل التخفّف من المشاعر النّافلة وزوائد الكلام. ولكي يتدارك النقد تأخّره المخزي بإزاء شعر سركون، هذا التأخّر الذي أشار إليه عبّاس بيضون في كلمته المنشورة في يوم الجمعة المنصرم عن سركون المريض، فعليه، أي النقد، أن يتعمّق في استقراء أسرار هذه البساطة ودوافع تأثيرها الفوريّ على الرّوح.
لم يعد الشاعر الكبير والصّديق الكبير والمشّاء الكبير بيننا، وإنّ رحيلاً مبكّراً كهذا لَيحفر في الرّوح هاوية عميقة. تظلّ لدينا أعماله، هي بمثابة وصيّته الشخـصيّة، وديعته المثمّنة التي نعود إليها مراراً وتكراراً، لننـهل بعـرفان المتـعلّم وصحوه من نقاء هذا الينبوع.
كاظم جهاد
المصدر: السفير


إضافة تعليق جديد