باريس عندما تتعرى
اذا كان انتباه الانسان الى عريه أولى علامات انتهاء زمن الفردوس بالنسبة اليه، فلا بد ان اولى علامات تصالحه مع جحيمه كانت انتباهه الى ورقة التين تلك. مذذاك سيكفّ العري عن كونه حالة ليصير فِعلاً. فِعلٌ فيه من القوة بقدر ما فيه من الض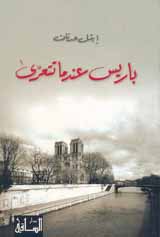 عف، وهو غواية بقدر ما هو هشاشة وعطوبية. الا ان عري المدن لا يشبه عري البشر، و"باريس عندما تتعرى" تفعل ذلك خارج "ثالوث الفردوس – المطهر - الجحيم"، صانعةً لنفسها حيّزها الخاص الذي تعيد فيه السؤال عن ذاتها في زمن انتفاء الحدود والتباس الهويات.
عف، وهو غواية بقدر ما هو هشاشة وعطوبية. الا ان عري المدن لا يشبه عري البشر، و"باريس عندما تتعرى" تفعل ذلك خارج "ثالوث الفردوس – المطهر - الجحيم"، صانعةً لنفسها حيّزها الخاص الذي تعيد فيه السؤال عن ذاتها في زمن انتفاء الحدود والتباس الهويات.
منذ العنوان الذي يشي بحركة ارادية ذات قصدية واعية، يضعنا نص إيتل عدنان الذي صدر بالانكليزية في 1993 ويصدر اليوم بالعربية لدى "دار الساقي" (ترجمة مي مظفر)، أمام كتابة تعرف كيف تكون مدينية ومعاصرة الى أقصى الحدود. كتابة لا تقصر نفسها على أسلوب وصفي تحنيطي يعمل على تظهير حالة سلبية ومتحققة، بل نراها تقارب موضوعها كفعل حركة وحياة ووجود، وذلك بنظرة حادة تخترق المدينة حتى صميم اشكالياتها المعاصرة.
"حين يهطل المطر في باريس، تفتح أوروبا مظلاتها. سريعاً، تُرمى صحف الصباح في السلال. القهوة تزداد كثافة مع القشدة، مما يجعلك تشتاق الى فيينا، وثمة رائحة خبز مطليّ بالزبدة تنبعث من المعاطف السميكة للرجال الذاهبين مسرعين الى مكاتبهم. في المترو ظلام وفوضى. في صفوف الركاب شابات كثيرات، بعضهن لم يقرأن قط Le Spleen de Paris. لا شك ان بودلير أحب لندن". منذ انطلاقه الذي يكاد يشبه فعل استيقاظ جماعياً للناس والاشياء والأمكنة، لا يناور النص في الاعلان عن ذاته ومقصده. الا اننا لن نقع في فخ التصنيف، ولن نفتش عن مكان بين الشعر والنثر نضع فيه هذا النص النابض بكآبة حية، لنطمئن الى ان لا شيء يشوّش الحدود الواضحة والنظيفة التي رسمناها في أذهاننا بين الانواع الادبية. ورغم ان الترجمة لم تنجح دائماً وتماماً في نقل عَصَبه الأصلي، وظلت بعض النتوءات اللغوية، اذا امكن تسميتها كذلك، تعوق انسيابه التام، فإنه ينجح في ان يخلق لنفسه قريناً بصرياً مشهدياً من صور تستعيدها الذاكرة او تبنيها المخيلة، لتتحول تجربة القراءة الى فعل يتعدى البعد اللغوي وحده ليكتسب أبعاداً سينمائية. قد نخال احياناً اننا ازاء شريط صوتي في فيلم عن باريس، ونكاد نسمع النبرة المستخدمة وطبيعة المشاهد المرافقة واللقطات المتتابعة.
تحلّ باريس في الكتاب بمعالمها الجغرافية والعمرانية والتاريخية والفنية والسوسيولوجية والثقافية، داخل بورتريه تصير فيه المدينة صنواً للذات الباحثة عن نفسها. تنتفي الحدود بين الداخل والخارج، وتختلط هموم العيش اليومي المبتذلة بتلك ذات الابعاد الاممية، ويتحول الاقتصاد والفن والسياسة والمناخ والمشاهد اليومية العابرة وسواها الكثير، الى ذرائع متعددة لحقيقة مدينية تتسع لتساؤلات الانسان المعاصر، الاخلاقية والوجودية والمعيشية. لا يعود ثمة فرق بين ان تقرر الذهاب الى المطبخ او الى كاليفورنيا، او بين شراء قطعة صابون واعلان حرب، ذلك ان "العملية الذهنية واحدة، والنتائج كذلك": أليست الحروب في النهاية "عملية تنظيف"؟
لكنها حقيقة مدينية ملتبسة هذه التي تكشف عنها الكاتبة. حقيقة ضبابية وماطرة وسامّة، قائمة أساساً على التناقضات، تجعل عشق المدينة عشقاً مؤرقاً ومشوباً بألف سؤال وسؤال، تقوده كآبة كفّت عن كونها حزناً رومنطيقياً كما تقول الكاتبة، لتتحول الى احساس "بالعجز والهزيمة". ذلك ان باريس الحرية وحقوق الانسان، هي نفسها باريس ذات الماضي الكولونيالي كلطخة يصعب تجاهلها على ضمير من يقترب منها، "فالقهوة التي نشرب، والمطاط الذي نتدحرج فوقه، والخشب الثمين الذي نشتري... منتجات تبعث على الريبة. لا نعرف هل سُدّدت اثمانها بمبالغ منصفة... او هل ابتزّت بطرائق "ديبلوماسية"". مع ذلك، فهذه العاصمة الامبريالية التي ترمز اليها الازهار "بالطريقة التي ترمز فيها "ازهار الشر" الى الشعر. أزهار القوة السامة"، هي عاصمة ذات وجهين ولسانين ورؤيتين، الاول متجه صوب الشرق والثاني صوب الجنوب، فهي "تظهر وجهاً شمالياً لدى مخاطبتها مستعمراتها السابقة. وفي تعاملها مع الانكلوساكسونيين، ترجع الى ثقافة البحر الابيض المتوسط، مازجة الاغواء بالقسوة".
من ناحيته، يحلّ الهاجس الأوروبي في النص باعتباره سؤالاً ثقافياً وفلسفياً مؤرقاً، وتحل تلك الـ"أوروبا" المخيفة والمشتهاة في آن واحد في مقاربة محكومة بحس فكاهة يضمر أكثر مما يعلن، فـ"لن تكون لك على الاطلاق خدود متوردة كخدود الاميرات الانكليزيات، ما لم يبدأ العمل في السوق المشتركة فعلاً"، كما انه "ليس في باريس ضباب يكفي لاقتراف جرائم انكليزية، او حالات عشق انكليزية". لكن الكاتبة اذ تعتمد هذه المقاربة، تفعل ذلك لتعمّق أكثر سؤال الهوية والحدود بين الدول، في عالم لم تعد الجغرافيا فيه مُعطى ثابتاً وأكيداً. فما معنى أوروبا وأين تبدأ وهل تنتهي عند باب المطعم الصيني في باريس؟ كلها أسئلة مشروعة ومشرّعة على تأويلات شتى لا يجدر ان تخدعنا خفّتها الظاهرة: "احمل مظلتك اذاً، واستعد معطفك المبلل، وعد ثانية الى الشارع الرطب، تحت المطر المنهمر، وابحث عن مكان يقدّم طعاماً صينياً او فيتنامياً بأسعار معتدلة. ولكن حذار، فإنك بدأت الآن تتخطى حدود اوروبا، واوروبا لم تُقم رسمياً بعد. عليك ان تنتظر حتى نهاية السنة".
لكن، بأوروبا او من دونها، تبقى باريس "اسبانية اكثر من اسبانيا، والمانية اكثر من القوطيين الغربيين، واكثر عروبة من مكة، واكثر ايطالية من دانتي، واشد صحراوية من الصحراء". الا انه بالنسبة الى هذه الكاتبة القادمة من تلك "الستينات الحبيبة" حيث "كنا نحلم بحياة تحتوي على سلع أقل عدداً"، بينما "الآن تأكلنا المادة لحماً نيئاً"، لا يلبث سؤال الهويات في أزمنة العولمة ان يتحول الى سؤال وجودي يطول الـ"أنا" في شكل لصيق: "لقد استعرت اللغة الفرنسية (وعليّ ان اقول ان احدهم اتخذ القرار عني)، وانا استعير مدينتهم، وأشتري أحذية يوغوسلافية، وسترات كشمير اسكتلندية، وجوارب ايطالية (مثلكم جميعاً). لن أتمادى أكثر لئلا أكتشف ان خلايا جسمي مصنوعة من لحم ارجنتيني وحليب هولندي". وفي ظل هذا التشتت الأنطولوجي الذي يصيب الأنا في زمن الهويات الضائعة والانتماءات الملتبسة، تبرز باريس كنقطة الاستدلال الموثوق بها الى وجودنا: "لا بد ان ابحث لي عن دين، دين بإمكانه ان يقول لي: لقد حدث انكِ وُجدتِ، وسيحدث انك لن تكوني. في الحقيقة، هذا ما تقوله باريس لكل شخص، انها تطلب منك ان تكون، الى اقصى مدى ممكن، ثم تقول لك في الوقت نفسه الا تكون".
يبدو نص ايتل عدنان على صورة المدينة نفسها، مكان يتسع لكل شيء. لكنه اتساع مؤلم، لأنه جوفي وجواني وغارق في ذاته ومنكبٌّ على الحفر في موضوعه وليس انفلاشياً ومفتوحاً الى الخارج: من مشهد امرأة تنزّه كلبها، الى مسألة العولمة وصراع الحضارات، مروراً بالموت في ذاته. من ميتران الى مالارميه مروراً بالمسألة الجزائرية وقوّادي الحي العربي. من الماضي الكاثوليكي الى معضلة الفرد وقيم الحرية والمدينية مروراً بالقنابل النووية الطليقة في الاتحاد السوفياتي السابق... هذا كله وأكثر، تحشده عدنان وتفسح المنطق لترابطه الذهني الذي يكشف في كل مرة عن الغريب والفذ والمفاجئ، ليصل أحياناً الى حدود هذيانية لا تخلو من غرابة وفكاهة: "المطر يعمّ جميع أنحاء أوروبا. ثمة ما يشبه شمساً مشرقة في الجزء الايطالي من اوروبا، لكن، هل صقلية أوروبية حقاً. هل نُدخل هذه الدول الجنوبية الحارة في اقتصادياتنا الشمالية؟ وهل يزداد المطر هطلاً هناك، حالما تكوّن أوروبا لنفسها جيشاً موحداً؟ لا احد في هذه الايام يملك رداً على اي شيء. ماذا لو حمل الروس شتاءهم الى الاجزاء الغربية من اوروبا؟ كيف نستيقظ في لجة صباحات ستوكهولم بتوقيت باريس نفسه؟ ينبغي حل مشكلات غير معقولة". لنصير ازاء نص يعرف كيف ينوّع نبرته بين التخفف والعمق، بين الفكاهة والفلسفة، من دون ان يفقد لحظةً حسه النقدي اللاذع: "ما الذي يجري في واشنطن؟ الآن بعدما سحق العراق، في وسعنا ان نفترض اسم الهدف المقبل. أندمّر ذات يوم بلداً بسبب الأداء الضعيف لكرة القدم فيه، نركلهم خارج العالم لأنهم وضعوا ايديهم على بعض المواد المدفونة تحت ارضهم؟ الله يعلم ما الآتي! بلى، هناك الكثير من البشر على الكوكب، لذلك فإن السؤال المقبل سوف يكون: اي امة ينبغي ان تختفي؟".
على هذا المنوال، وعلى طول فصوله الاربعة والثلاثين التي لا يتعدى أطولها الاربع صفحات وتحمل كلها العنوان نفسه وهو عنوان الكتاب، يسترسل النص كما لو كان يتناسل ذاتياً، كأني به يغرف من ذاته ويتغذى منها، فيولد وينضج ويذوي ويموت في المكان نفسه قبل ان يعيد الدورة نفسها مرةً أخرى. وهو في مساره هذا، قد يكون شبيهاً بعض الشيء بنافورة ريلكه ورمزيتها الوجودية. واذا كانت ايتل عدنان لا تأتي على ذكر ريلكه، الا انها تتحدث عن نظام الاشياء الدائري، نظام الحياة نفسها والكتابة والانسان والمدن ايضاً: "هل حُكم علينا ان نمضي في دوائر؟ أحب الحركة الدائرية التي تعيدني ثانيةً الى كل ذلك الذي أتفاداه"، تقول، ثم تضيف في مكان آخر عن باريس: "هي لا تنتمي الى ذاتها، وليس لها انتماء. ومن اجل ذلك فإنها دائرية". لهذا السبب ربما يحلّ عنصر المطر في النص كما لو أنه نقطة الاستدلال الى الذات والمدينة على السواء، لكونه الرمز الاكمل لهذه الدورة التي لا تنفكّ تعود كل مرة الى نقطة البداية.
"باريس ليست طفلة. انها تبدو ناعمة، غير ملتزمة، لكنها تخفي في احشائها ارادة حديدية"، تقول ايتل عدنان في مكان ما من "باريس عندما تتعرى"، فإذا بها تكتب هذه المدينة كما لو كانت تريد النفاذ الى روح كائن حي. لكنها تفعل ذلك خصوصاً بوعي مكاني وزمني حاد لا يني يتوسّع ويتضخّم، حتى ينتهي الى فقدان كل احساس بالزمان والمكان نفسيهما، فلا يعود "في وسع احد ان يخمّن الشهر واليوم والساعة"، وتصير في حاجة "الى عصا تسندك لتعرف كم الساعة، وتشتري الصحيفة لتعرف تاريخ اليوم في التقويم".
سيلفانا الخوري
المصدر: النهار


إضافة تعليق جديد