باتريك موديانو: لا يمكن للمرء أن يكون قارئ نفسه
لم تتفاجأ الأوساط الثقافية كثيراً في فوز الروائي الفرنسي باتريك موديانو بجائزة نوبل للآداب. عديدون هم الذين اعتبروا أنه يستحقها إذ نحن أمام كاتب عرف كيف ينسج فضاءه الخاص به، وكيف يكتب رواية لا تمت بصلة إلا إلى نفسه. بمعنى أنه كاتب متفرد، عرف عبر قضايا الذاكرة والهوية، أن يعيد إحياء عوالم متكاملة، عوالم روائية حقيقية، تستفيد من السيرة الذاتية لكنها لا تقع أبدا أسيرة هذه المنطق الكتابي.
ما يحاوله موديانو في كتاباته، أن يفرد أيضا مساحات كبيرة للمتخيل، وإن كانت ثمة صورة ما «واقعية» تكون السبب في كتابة أي رواية. في أي حال، وبعد أن قدمنا في السفير الثقافي من الأسبوع الماضي، لمحة عن أبرز الموضوعات التي تطرق إليها الكاتب في أعماله، أختار هنا أجزاء من حوارات متفرقة أجريت مع الكاتب، من مجلات «تيليراما» و«لونوفيل اوبسرفاتور» و«لوبوان» وغيرها، وهي تعود لتواريخ متعددة، لأدمجها ببعضها البعض كي تشكل سياقا واحدا، الهدف منه تقديم لمحة إضافية عن تفكير هذا الكاتب. فالحوارات الصحافية، تضيء أيضا بدورها كثيراً على طريقة تفكير أي شخص.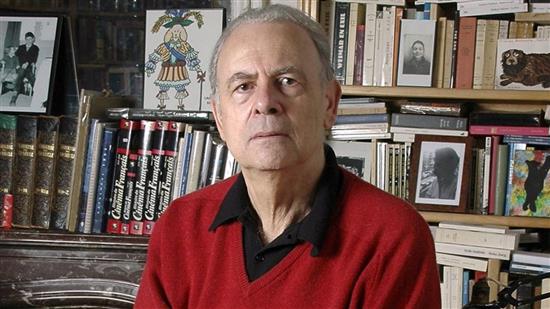
÷ اعترفت أحيانا بأنك كنت تحب أن تكتب روايات بوليسية، كتابك الأخير يبدو تقريباً كأنه كذلك؟
} أجل تملكتني الرغبة دائماً، تملكني الحنين في أن أكتب روايات بوليسية. أو مسلسلات، كما كان يفعل جورج سيمنون، الذي كان يقدم رواية جديدة كل شهر. في العمق، تبدو موضوعات الرواية البوليسية قريبة من الموضوعات التي أهجس بها: الاختفاء، مشكلات الهوية، فقدان الذاكرة، العودة إلى الماضي المليء بالألغاز. هناك أيضا واقع أنها تقترح علينا أغلب الأحيان شهادات متناقضة حول شخص ما أو حول حادثة ما، وهذا ما يجعلني قريبا منها. إن ميلي إلى هذا النوع من الحبكات يمكن تفسيره أيضا بأسباب حميمية. لو عدت إلى الوراء، لبدا لي أن أحداث طفولتي كانت تشبه الرواية البوليسية. في بعض الأحيان، كنت محاطا بأحداث غريبة جدا. الأطفال لا يطرحون عادة هذا الكم من الأسئلة حول اللحظة الراهنة، إذ يبدو لهم كل شيء طبيعيا. لكن في فترة لاحقة، حين بدأ الزمن بالانسياب، نستدير إلى ماضينا لنتساءل: ما الذي جرى بالضبط.
÷ ولِمَ لم تكتب إذاً رواية بوليسية؟
} لأن الرواية البوليسية تتطلب نوعا من الواقعية، بالأحرى من الطبيعية، مثلما تتطلب حبكة سردية قاسية وفعالة. ليس هناك، في طريقة صوغها أي مجال، للجانب المنساب للحلم، علينا أن نكون واقفين على الأرض، أو تعليميين، كي تتماسك قطع «البازل». في نهاية الرواية البوليسية، نجد شرحاً، حلا. وهذا أمر لا يتناسب حين نرغب، كما في حالتي، في أن نصف ماضيا مشتتا، غير متيقن، حلمياً. ومع ذلك، فأنا لا أكتب حقا روايات بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، بل بالأحرى أشياء مائلة (غير مستقرة)، نوع من أحلام اليقظة، تنبثق من المتخيل.
بعيدا عن السيرة الذاتية
÷ هل تتذكر الفكرة الأولى التي قادتك إلى هذه الرواية؟
} وجدت يوما ملحوظة صغيرة كتبتها وأنا طفل، في الثانية أو الثالثة عشرة من عمري، قلت فيها عن رغبتي بمحاولة كتابة شيء يكون بمثابة مزيج ما بين «مولن الكبير» والرواية السوداء على طريقة بيتر شيني. وذلك انطلاقا من لحظة متاعب عرفتها في طفولتي قبل سنوات، حين كنت أسكن في ضواحي باريس، في «السين ايه واز»، في ضاحية كانت لا تزال ريفية بعد وإلى القرب منها آثار قصر يذكر بألان فورنييه. كان والداي غائبين، والأشخاص الذين كنت أسكن عندهم كانوا مبهمين، والمناخ غريب. في كتاب قديم بعنوان «إعفاء من العقوبة»، نشرت قبل 25 سنة، تحدثت عن هذه اللحظات.
÷ ومع ذلك تبقى بعيدا عن السيرة الذاتية؟
} الأمر بالنسبة إلي، لا يكمن أبدا في أن «أغطس» بطريقة نرجسية في طفولتي. لا أكتب أبدا كي أتحدث عني أو أن أحاول فهم نفسي. ولا من أجل أن أعيد تركيب الوقائع. من من رغبة عندي أبدا في القيام بمحاولة استبطان. ابدا، القضية هي أن محيطا، مناخا ما وسمني خلال طفولتي، وأحيانا هناك أحداث استفدت منها كي أكتب عبرها الكتب. تركت المخطط العائد للسيرة الذاتية كي أموضع نفسي في المتخيل، في الشعرية، مستفيدا من بعض أحداث طفولتي لأجعلها القالب. ثمة أشياء ساخرة أحيانا، بدون معنى.. أذكر على سبيل المثال أنه في أولى المجلات التي قرأتها خفية وأنا في العاشرة من عمري، وقعت على صورة امرأة تمت محاكمتها لأنها قتلت عشيقها، وكان طالبا في كلية الطب. لقد سكنني وجهها لدرجة أنه بعد تلك الحادثة بسنوات، تعرفت على وجهها بينما كنت أسير في شارع دراغون في باريس. لا أبحث على معرفة لمَ هذا الوجه صدمني، ما يهمني هو أنه يرميني في حلم.
بالطريقة عينها، الأسئلة التي كنت أطرحها على أهلي وعلى تصرفاته الغريبة، على الشخصيات المختلة التي تحيط بهم، على الاحتلال، هي أسئلة لم أعرفها ولكنها كانت حاضرة بالنسبة إلي مثلما كانت حاضرة بالنسبة لأبناء جيلي.. كل ذلك، لم أبحث عن توضيحه، بل في أن أضعه في بيان شعري. ليس للأحداث أهمية في ذاتها، بل إنها بمثابة مرايا عاكسة بالنسبة إلى المتخيل والحلم. فبالطريقة التي حلمنا بها، بالطريقة التي نمزجها ببعضها، فإننا بذلك نضع عليها نوعا من الفوسفور، نحولها. حين أكتب بهذه الطريقة، أشعر بأنني أقرب إلى نفسي من أن أكتب فقط من وجهة نظر سيرية ذاتية.
÷ العمل الوحيد من بين كتبك الذي يضطلع بمفهوم السيرة الذاتية هو كتاب «سلالة»؟
} يمكن اعتبار الأمور على هذا النحو. ومع ذلك، وللغرابة، هو كتاب لا أتحدث فيه عن أشياء أو عن شخصيات حميمة. في الواقع كتبت هذا الكتاب كي أخفف من وطأة من فرض نفسه علي في هذه الحياة: أهلي، الأشخاص المحيطون بنا حين نكون أطفالا ومراهقين، الذين لم نخترهم لكنهم حاضرون ويثقلون عليك. أردت فعلا التخلص منهم، كما نفعل ذلك مع جسد غريب. كتبته بعد أن قرأت كتابا عني يتضمن الكثير من عدم الدقة. قررت، بمعنى وثائقي، أن أشيد نصبا تذكاريا، دقيقا حول طفولتي ومراهقتي. عملت عليه لمدة عشر سنوات كي يصبح مقبولا للنشر. وقد أفضى ذلك إلى كتاب جوهري، «سلالة»، وقد ندمت لفترة على نشري إياه، بالضبط بسبب هذا الجانب الأشبه بفاتورة وبسيرة ذاتية. أضف إلى ذلك انه حدث أمر غريب: لقد جاء الكتاب وكأنه استنشق كتبي الأخرى، فهو لا ينفك عنها، بدأ وكأنه هيكل كتبي الأخرى.
÷ تقول عن «سلالة» (صدر العام 2004) إنك كتبته مثلما نكتب محضراً، أي بهدف توثيقي ولكي تنتهي، بدون شك، مع حياة لم تكن حياتك. لقد صفيت حسابك فيها، مع والدك. كما تستدعي، عبر سطرين، موت أخيك رودي. هل غيّرك هذا الكتاب، هل حررك من ثقل ما؟
} أشعر بالحيرة. إذ على الرغم من أني تخلصت في الواقع من العديد من الأشياء التي كانت تزعجني، إلا أني لم أكتب في سلالة الكتاب الذي رغبت في كتابته، لم أكن جديرا بصناعة ما يدعى سيرة ذاتية. ما عدا السطرين عن أخي، أشعر بأني غريب تقريبا عن ذاك الذي يروي شبابه. أحسد الكتّاب الذين يتكافلون مع ذواتهم الذين يجدون أنفسهم لطفاء. لست كذلك، للأسف. بدون شك لأني أشعر باضطراب بأني غير مسؤول عن حياتي، مثل الكلب غير المسؤول عن سلالته. لقد فرضت عليّ، هذا كل ما في الأمر. إني غريب عنها جزئيا. من هنا جاءت نبرة الكتاب. لطالما رغبت في أن أروي طفولة سعيدة وعن عائلة متناغمة.
÷ أي انك تجد نفسك أنك أكثر شبها في الرواية منه في السرد، وفي المتخيل أكثر من الواقع؟
} بالضبط..
أدراج الذاكرة
÷ إن اعتبرنا «سلالة» هيكل كتبك الأخرى، كما تقول، لا بدّ أن نجد أن كتاب «فيما أبعد من النسيان»، وكأنه مقدمة لجميع أعمالك..
} أجل.. في الواقع لقد شككت دائماً بإمكانية إعادة إحياء الماضي.. لكنّ الأمر الوحيد، انه هناك.. بعض المناطق التي أكلها النسيان، وبرغم ذلك، تبقى بعض المقاطع عالقة، بعض الآثار.. انه عمل كتجميع الأعضاء، فالكتب تولد دائماً بشكل غريب.. في أي حال، عنوان كتابي هذا يستعير بيتاً من أبيات الشاعر ستيفان جورج، وهو أحد معاصري ريلكه، وكان قد ترجم فيما مضى، إلى الألمانية، الكثير من الشعراء الرمزيين الفرنسيين.
÷ تبدو هنا، وكأنك تعيد فتح درج قديم، سرّي، وكأنك تحفر ذاكرتك بشكل أعمق. هل كتابك هذا، رواية كلفتك كثيراً على المستوى الأخلاقي؟
} ليست الرواية بالتحديد، بل الانطباعات.. ما أحاول القيام به دائماً مرتبط بالزمن، أكثر من الذاكرة.. لكن الأشياء ملوثة بالصمت. وهذا أمر عبثي.
÷ ما إن نبدأ قراءة روايتك، حتى نشعر أن كلّ شيء محدد مسبقاً. انك لا تصل أبدا إلى تركيب هذا «البازل» وغالباً ما نشعر انك كنت على استعداد لأن تترك كل شيء. هل هذا صحيح؟
} يعني ذلك أن الكتابة مرتبطة بمجموعة من خيبات الأمل المتعاقبة، ففي كلّ مرة أتوه فيها داخل حلبة خاطئة.. عليّ أن أتخطى فشل اللحظة.. رغبة التواصل من جديد، إعادة الإمساك بالخيط.. وصل القاطرات ببعضها البعض. فالحبكة مصنوعة من عدة متواليات.. انه عمل طويل.. وعلى المرء أن يتحلى بمميزات عميقة.
÷ تقول إن كتابة رواية هو القيام بمخطط ومن ثم أن يترك المرء نفسه يضيع في الذكريات. لكنك تتحدث دائماً عن عمل الكتابة الصعب. أين الحقيقة في ذلك؟
} إنه «حمام اسكتلندي» (أي نبأ أو كلام مزعج يأتي بعد نبأ أو كلام مفرح).. فحين تسقط الإثارة يفقد المرء أعصابه ومع ذلك على المرء أن يستمر. كما لو أنّ على المرء أن يحصل على مشاهد حب وأن يعيدها باستمرار، انه أمر شاق. حين ينقل أحدهم الأحاسيس، فإنه لا يبرهن على شيء ومع ذلك عليه أن يعطي العاطفة.. للقيام بذلك خلال الاسم، أمر سهل، لكن في الكتابة، فهذا أمر لا ينتهي.. انه جبل يتمخض فيلد فأراً.
نضوب الخيال
÷ هل تشعر بأن عودتك باستمرار إلى الموتيفات ذاتها، تشعرك بالخوف من أن يكون خيالك قد نضب؟
} لا ننتبه إلى أننا نستعيد دوما الموضوعات والصور التي سبق أن كتبنا عنها إلا لاحقا. هذا أمر يأتي بطريقة غير واعية، بيد أنه تأتي لحظة ـ ولكثرة ما نستعيد فيها الموضوع ـ نخشى بأن الأمر لن ينجح. كان فوكنر يقول إن الكتابة هي استهلاك حلم. يمكن لنا أن نتجنب هذا الشيء.
÷ تكتب منذ خمسين سنة تقريبا، ويبدو أنك اجتزت كل هذه السنين وكل هذه التيارات الجمالية التي تعاقبت من دون أن تصاب باللوثة..
} في الستينيات، كان أبناء جيلي الذين يرغبون في الكتابة لا يهتمون بالرواية، ولا بالأشياء الأدبية الصافية. حين بدأت الكتابة، اتجهوا هم إلى العلوم الإنسانية.يبدو لي أنهم كانوا بحاجة إلى معلمين، بأن يقادوا ثقافيا، من هنا أصبحوا مريدين لبارت أو فوكو أو ألتوسير. بالنسبة إليّ، كانت رؤيتي رؤية روائي، جعلتني بعيدا دائما عن النظريات. يهمني هؤلاء المعلمين كشخصيات، أهتم بتفاصيل تعابيرهم، بشخصياتهم، ولكن لا اهتم أبدا بفكرهم. أذكر أني صادفت يوما جاك لاكان وبأني راقبت حركاته، صوته، طريقته في الكلام. قد يبدو هذا الأمر أرعناً، لكني أضطلع به.
÷ ألم يشدك التحليل النفسي يوما؟
} التحليل النفسي يشبه أحيانا الرواية البوليسية: ثمة شيء خبيء لا نريد أن نراه أو لا يمكننا أن نراه، لذلك ننتظر أن نكتشف ما سينبثق من سيرورة التحليل. إنه أمر قريب من التحقق...
÷ تعيش شخصياتك جانبياً. كأنها في «أكواريوم بلا ماء»..
} هذا صحيح. إنها حضور وغياب في الوقت عينه. كما في تلك الأحلام المضطربة حيث نطير وحيث لا نصل دائماً إلى اللحاق بالقطارات التي تمضي. ليس في الأمر أي شيء واقعي، إنها نظرتي الخاصة بالإحساس أنه في وقت ما، كان كلّ شيء متخفياً كأن لا نستطيع أن نقوم بأي شيء، فالعديد من الأمور ممنوعة.
÷ هل أن كتابة الروايات ذاتها وأنت في هذا العمر، كما كنت تفعـل حـين كنت في العشرين، يمثل لك نعمة أم رعباً؟
} حتى وان كنا نقول الأشياء ذاتها، فبإمكاننا دائماً أن نبدل شريط التسجيل.. إن النشاط الروائي الصافي محكوم بالزمن بشكل كبير.
÷ كّنا شبانا، لم يكن لدينا ماضٍ نكشف النقاب عنه. كنا نعيش الحاضر، تقول إحدى شخصيات رواية «في مقهى الشباب الضائع». لماذا تمضي وقتك، من كتاب إلى آخر، وأنت تحاول إقناعنا بأنك تعيش في الماضي؟
} أعطي دائما الانطباع بأني أنحني صوب الماضي، صوب فترة الاحتلال، إلا أن هذه المسيرة مرتبطة بجيلي. ولو لم أقم أنا بذلك لقام بالأمر شخص آخر.
÷ ألا تشعر بأنك تكتب الرواية عينها دائما؟
} بالتأكيد. أستعيد الأسماء عينها دوما. لكن في الواقع لا يشكل الأمر تكرارا، بل مخططات أعود إليها بدون توقف.
÷ كيف تنظم أيام عملك؟
} أيام من الحلم.. وساعة من العمل الحقيقي. لكن حين تكتب يخف الضغط سريعاً، ويرتخي الوعي، وتبهت الصورة، وعليك أن تبحث عن اندفاع جديد. هناك أشخاص يقولون إنهم يستطيعون الكتابة طوال ليال بأكملها، أما أنا فأتعب بسرعة.
ستارة حديدية
÷ تقول عن الخريف انه ليس فصلا حزينا بل ثمة كهرباء في الجو.
} في الواقع أشعر بأن الصيف فصل قاس، ميتافيزيقي. يذكرني دائما بروايات بافيزي. أما الخريف، وبخلاف ذلك، وعلى الرغم من الأوراق الصفراء وقصر النهارات، إلا أن كلّ شيء يبدأ فيه من جديد، كل شيء يصبح فيه ممكنا، كل المشاريع مسموح بها. لا أجده كلحظة كئيبة بل على العكس كلحظة مثيرة ومطمئنة في الوقت عينه. لا يصيبني الخريف بالقنوط أبدا، بل يعطيني الرغبة في الكتابة، في البحث عن نقاط ثابتة مثلما يفعل الآخرون مع الكلمات المتقاطعة.
÷ تتحدث أحيانا في كتبك عن نهر السين بصفته خط تماس، ستارة حديدية بين ضفتي باريس، لماذا؟
} حين أمرّ على الضفة اليمنى، أشعر بأني أدخل إلى فضاء من الحرية كما أيضا إلى مغامرات مقلقة. الأمر عائد إلى ذكرى محددة عن مركز للشرطة كان موجودا في ساحة اللوفر، بالضبط قبل شارع الريفولي. يبدو ذلك بالنسبة إلي وكأنه مركز للجمارك. كنا نصل إلى الضفة اليسرى عبر جسر الفنون الذي كان ساحرا. وبخلاف ذلك لم أكن أستطيع أن أصل إلى الضفة اليمنى، على الأقل من خلال ذاكرتي، وأنا طفل في الرابعة عشرة، والتي كانت لا تزال ذاكرة متناثرة، إلا عبر اجتيازي لهذه الجمارك المعتمة التي تقع تحت حراسة الشرطة... وما إن نجتازها حتى نصل إلى حي «الهال» الرائع، شارع الصحف والشوارع الشعبية.
÷ أليست هناك أماكن جديدة في باريس يمكن لنا أن نجعلها ساحرة؟
} بلى، ربما ناحية مكتبة فرانسوا ميتران، هناك بعض الأشياء الميتافيزيقية، المرتبطة بالفضاء، بنهر السين، بأنوار الليل.
÷ تقول هناك وسيلة للنضال ضد النسيان، تكمن في الذهاب إلى أماكن في باريس لم تزرها منذ ثلاثين أو أربعين عاما، وأن تبقى فيها طيلة فترة بعد الظهيرة كما لو أنك تقوم بالمراقبة. هل هذا أمر لا تزال تقوم به اليوم؟
} كلا، لم أعد أخرج كثيرا، اشعر بأن الحي الذي أسكن فيه لم يعد لديه أي علاقة مع ما أنا عليه. لقد أصبح حيا للحوانيت، لم تعد الأشباح موجودة هنا، أو ربما هي في عمري تقريبا (يضحك).. أفكر بشارع فور. في الخمسينيات، كان شارعا هامشيا، ذا صيت شيء تقريبا، نلتقي فيه بكل الأشخاص غريبي الأطوار. من الحماقة أن نتكلم بهذه الطريقة...
÷ تقول إنك تكتب مثل سائق يقود في الضباب.
} أجل، لا يعرف إلى أين يذهب، فقط يعرف أنه مجبر على التقدم.
÷ لماذا؟
} لأنه لا يمكن القيام بأي شيء آخر. أخشى أن أترك كتابا على الطريق. كيف أشرح هذا، ليس خوفا من فشل داخلي، أبدا، الخوف من أن التخلي عن كتاب قد يحطم شيئا في العمق، أن يجبرني على استعادة كل شيء من البداية، وأن أجد نفسي غير جدير بالقيام بهذا، أي أن أبدو كقافز السيرك الذي يرمي نفسه بالفضاء كي يصل من ضفة إلى ضفة. إني أصل المقاطع ببعضها بعض، نخترع علاقات، تصنع الرواية عبر المقاطع، كما القاطرات التي تربك ببعضها. هل تفهم عليّ؟
÷ أجل
} هذا العناد يتأتى أيضا من واقع أني فقدت مخطوطا، منذ زمن طويل، أولى مخطوطاتي، التي كتبتها قبل «ساحة النجمة»، وكنت أتمسك بها جيدا.
الكتابة
÷ كيف فقدت هذا المخطوط؟
} لا أعرف بالضبط.. كنت في مدرسة داخلية وقد تم طردي لأني قرأت كتابا لكوليت، يتراءى لي أني وضعت المخطوط عن أناس كي يحتفظوا لي به.. لا أعرف إن أضاعوه أم أنا الذي أضعته؟ لم أجده مجددا أبدا.
÷ تبدو كأنك تجد اليوم اقل صعوبة في الحديث عن كتبك وعن نفسك مما كنت عليه في بداياتك؟
} هذا صحيح
÷ كيف تفسر الأمر؟
} في بداياتي، كنت أتلقى الكتــابة وكأنها نوع من الإرغام، أن تبدأ الكتابة باكرا، فهذا أمر مرعب، إنه يتخطى قواك، عليك أن تحمل أشــياء ثقيـــلة وأنــت لا تملك الوسائل لذلك. مؤخرا، أعدت رؤية مخــطوطاتي الأولى، وتفاجأت بغياب المساحات بين الخطوط، لا مجال للتنفس. هكذا كانت حالتي النفسية يومها، اليوم الضغط يبدو أقل حدة.
÷ هل أن الكتابة نشاط مستحب؟
} ما أحبه في الكتابة هو حلم اليقظة التي يسبقها. الكتابة بحد ذاتها لا. علينا أن نحقق الحلم على الورقة، أي الخروج من هذا الحلم.أحيانا أتساءل كيف يفعل الآخرون؟ كيف أن أولئك الكتاب، مثل فلوبير كانوا يقومون به في القرن التاسع عشر، من كتابة وإعادة كتابة، كيف يؤسسون ويبنون ويكثفون انطلاقا من الدفعة الأولى التي لا يتبقى منها شيء في صيغة الكتاب النهائية. يبدو لي الأمر مرعبا. أنا شخصيا، أسرّ في حمل تصحيحات على الدفعة الأولى، التي تشبه رسما تم رسمه دفعة واحدة. هذه التصحيحات هي في الوقت عينه كثيرة وخفيفة.. أجل علينا أن نقطع كجرّاح، أن يكون المرء باردا تجاه نصه كي يصححه ويخففه ويقطع منه. يكفي أحيانا أن تشطب كلمتين أو ثلاثاً على صفحة كي يتغير كل شيء. لكن كل ذلك، يشكل مطبخ الكاتب، أمر يثير ضجر الآخرين.
في كتبي الأولى، لم تكن هناك فصول أبدا، من عودات إلى بداية السطر، من تنفس. فيما بعد، تساءلت عن سبب ذلك، وفهمت أن الكتابة لا تناسب الشباب أبدا. إلا في حالة نبوغ شعري كبير مثل رامبو. أن نكتب ونحن شبان، مثل أن نخضع لضغط لا نعرف كيف نتحكم به. انظروا إلى هؤلاء «العتالين» الذين يمكنهم رفع أوزان غير معقولة على أكتافهم وظهورهم، لأنهم يعرفون أي نقطة توازن في أجسامهم عليها التكيف مع هذا الحمل. الكتابة شبيهة بذلك: علينا أن نجد نقطة التوازن. في البداية لم أكن أنجح في ذلك، كنت قلقا، متوترا، وليس من السهل أن تركز على هذا الأمر. أضف إلى ذلك، كما لو أنه هناك نقص في السائل العصبي ما بين الدماغ واليد: نفكر بأشياء تحفزنا، وحين نبدأ الكتابة، بطريقة ما، يبدو أن الوقت قد فات، إذا تفقد هذا السائل العصبي، تصبح عندها مثل تلك البطات التي قطعت لها رؤوسها لكنها تستمر في الركض بدون رؤوس.
لم أتعلم التحكم بذلك إلا مع مرور السنوات، بأن أخفف من توتري، بتهوئة رواياتي. الكتابة ليست أمرا سهلا أبدا، لكننا نمتلك مع الأيام تقنيات تجعلنا نقوم بذلك، بل حتى أننا ننجح فيها أكثر.
÷ ما هي العلاقة التي تحتفظ بها مع قرائك؟
} من المثير أن يكون لدينا قراء. أمر ساحر، نشعر وكأنه يمكننا التخاطب. في الواقع، عند كل كتاب أصدره يحدث أمر ما، ربما متعب قليلا: حين تنهي الكتابة تأتي لحظة فجة يرغب فيها الكتاب ان يقطع الجسور معك، أن يتخلص منك. لا يمكن للمرء أن يكون قارئ نفسه. لقد انتهى كتابك وأصبح شيئا، نوعا من خليط، كتلة لديك عنها نظرة لبعض تفاصيلها، لا نظرة شاملة. إنه القارئ الذي سيظهر هذه الرؤية، كما يحدث الأمر في الصورة الفوتوغرافية. لا ينتمي الكتاب لكاتبه، بل لمن يقرأه.
اسكندر حبش
المصدر: السفير


إضافة تعليق جديد